 تجلّيات أزمات الواقع والتكثيف الرمزي
في رواية (اخترتُ إلها)
تجلّيات أزمات الواقع والتكثيف الرمزي
في رواية (اخترتُ إلها) |
| تجلّيات أزمات الواقع والتكثيف الرمزي في رواية (اخترتُ إلها) |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص : د. سمير الخليل تمثّل رواية (اخترتُ إلها) للروائي عبد الزهرة علي أنموذجاً للرواية القصيرة المكثفة التي تتخّذ من أسلوب الإختزال والتكثيف مرتكزاً لها، وعلى الرغم من هذه المساحة الإختزالية والميل إلى التكثيف الشديد فإنّها قد انطوت على تجسيد أحداث وانعطافات ودلالات لمراحل تاريخية متعدّدة، وتعمّق كثيراً في رصد الواقع المحتدم والمأزوم والرّث، وتأطيراته الملتبسة على وفق صياغة سردية للكشف عن بؤر الاختلال والارتكاس والتأزم والرؤى المعتمة التي تحيط بكلّ تفاصيل الحياة والشخصيّات والأمكنة من أزمات وتداعيات ومفارقات استطاع الروائي فيها أن يكون نابهاً ذكيّاً، ويرتكز الخطاب السردي في الرواية على وجود كثير من الثيمات والمضامين الإنسانية وهو يسلّط الضوء على فكرة التسامي الديني والإنساني، ومحاولة وضع رؤية متوازنة ودالّة للجمع بين الأديان والمذاهب، وجعلها تنصهر في بوتقة التوّجه الإنساني، ورقي العقل وتحقيق تناغم يلغي كلّ الفوارق والتطرّف، ويسعى الجميع إلى الانفتاح وقبول واحتضان الآخر. وتكشف سيميائية العنوان عن هذا المتجّه الإنساني والفكري ويصبح (الإله) أو الدين العظيم هو المرتبط بدين الإنسانية، وخلق هوية عابرة لكلّ هذه الفوارق التي من شأنها بثّ روح الكراهية ومحو الآخر ممّا يؤدي إلى تلاشي الهوية الإنسانية والوطنية ويتحوّل المجتمع إلى شريعة الغاب، ويمثّل (آدم) بوصفه الشخصيّة الرئيسة أو المركزية في الرواية انموذجاً لرقي الإنسان، وبحثه عن التناغم بأرقى أشكاله فهو يجسّد المثل الإنسانية بغض النظر عن الانتماء الديني والتشظّي الهوياتي ولم يصل إلى هذه الذروة من التسامي والتوازن إلاّ بعد مجاهدة وصراع داخلي، واسئلة وجودية وبحث مستميت عن فكر روحاني ومعرفي يكشف عن الحقيقة المتعالية والسامية، ونبذ كلّ أشكال القبح والإرتكاس والرؤى المعتمة ويكشف أن التنوير الحقيقي يكمن في اكتشاف أسرار النفس وإيمانها بيقين إنساني، يضعها في موقع الترّفع والنبل والإرتقاء، ويجعلها تكشف أنّ النزعة أو العروج إلى فكرة الإنسانية هو مفتاح العثور على النفس وعلى الآخر والتصالح معهما، ولعلّ اسم (آدم) يغطيّ مساحة الإنسان أينما يكون فهو الإنسان بلا اسم محدد، فآدم في الرواية مسيحي يعيش في منطقة الدورة وتحديداً في حي الآثوريين وينتمي لأسرة تؤمن بتعاليم الدين المسيحي، وعمّه مطران متعمّق باللاهوتية ويعمل في كنيسة في مدينة الموصل وعلى الرغم من عمل أبيه موظفاً غير أنه أراد لآدم أن يسلك مسلك العم، لكنّ آدم استعرت فيه أسئلة ورؤى، وتحرّكه ذاته لاكتشاف حقيقة النفس وحقيقة الوجود، وحقيقة البحث عن التوازن والإعتدال وعن رقيّ الذات وتجاوز اليقين التقليدي المنغلق، وتبدو شخصيته تميل إلى البحث عن الحقيقة السامية ممّا يجعله في صورة التمرد من وجهة نظر البيئة المحافظة التي يعيش في كنفها، ويقوده هذا التفكير التنويري إلى أسئلة وبحث دائب عن كثير من الأفكار والتساؤلات المرتبطة بالدين والواقع والذات والآخر، وهو يشعر بأن الوصول إلى مرحلة اليقين تقوم على وجود الإنسان المدرك والمجسّد للنقاء والعشق الحقيقي للعدالة مما يجعله يعيش في خضم دوامة من الأسئلة والقلق وبحثه عن اليقين والتوازن وإمساك الخيط الذي ينقذه من هذه الأزمة التي غالباً ما يكابدها الإنسان الحقيقي المنتمي إلى انسانيته قبل كلّ انتماء: "كنتُ أدور مثل فراشة حول النار، فإنْ اقتربتُ من الإله الذي أرغب احترقت، وإن ابتعدت عنه ضاع حبي وأملي، بقيت متردّداً أو خائفاً وقلقاً، بانت قبالتي صورة الإنسان الهشّة واضحة وجليّة، عاودت اصراري لتشكيل روحي الذائبة في العشق، أن أكون عاشقاً للإله كما أنا عاشق لحبيبتي..." (الرواية: 6). والمقطع السردي يكشف عن واحدة من أزماته التي وجد نفسه في مخاضها القاسي حين قادته مشاعره المتأجّجة إلى عشق فتاة تسكن بالقرب منهم واسمها (حواء) ويكتشف أن هذا النوع من الحب المحرّم تحاربه رجالات الأديان، فكيف يعشق المسيحي الكاثوليكي فتاة مسلمة في مجتمع قائم على أوهام الصراع وخلق الفوارق وانتاج الكراهية وعدم قبول الآخر؟ متناسين البعد أو الفكرة الإنسانية التي ينطوي عليها الحب بمختلف أشكاله وتجلّياته، وقد عُدَّ (آدم) متمرداً على التقاليد والوصايا فهو لم يكتفِ بعدم الميل إلى الطقوس والوصايا الدينية والتقاليد الكنائسية بل ارتكب إثماً بعشقه لفتاة مسلمة، ويباغته هجوم أم (حواء) وتهديدها له بأن عندها أربعة أخوة سينالون منه، وحين صرخ بوجه أهله أنه يحبّها كان الرد قاسياً: "- ماما... أحبّها.. حاولي مع أبي أرجوك... – كافي عاد تعّبتني، انت تطلب المستحيل. صرخت بصوت منكسر: - علينا تحطيم هذا المستحيل الذي صنعناه بأيدينا يا أمي. قلت لها وأنا أمسك رأسها وأقبّل جبهتها البيضاء التي بانت عليها تجاعيد السنين: - اسكت بلا كلام... كفى صبيانيّة، أنت شاب مشاكس تريد أن تحرق المنزل بنيران حماقتك..." (الرواية: 32)، وهذا هو سبب ابعاده إلى الموصل وإلى عمّه المطران وإلى أجواء الكنيسة، ونشير إلى أن اسم (حواء) فيه دلالة عامّة على كل النساء مثل (آدم) الذي يدل على الإنسان عموماً وقبل أن نكمل تفاصيل المتن الحكائي والحبكة الفنيّة لابُدَّ من تأشير بعض الظواهر الفنيّة في البنية السرديّة فضلاً عن أسلوب الاختزال والسرد المركّز، فإن الروائي عمد إلى تقسيم الرواية إلى فصول ووظف لكلّ فصل عنواناً دالاًّ مرتبطاً باسم شخصيّة من شخصيّات الرواية مثل (آدم) (حواء) (جانيت)، (الدرويش)، وهناك عنوانان معبرّان عن أحداث الرواية هما (الصراصير) و (العودة إلى بغداد)، وكل فصل يكشف عن طبيعة ودواخل الأحداث المرتبطة بالشخصيّة وبشكل اختزالي أيضًا. برع الكاتب بوضع خط او خيط درامي متصاعد من خلال كلّ فصل واستطاع تقديم تقنية المونتاج السردي بالانتقال بين الأزمنة لاسيما الماضي والحاضر مع وجود إحساس ينبئ بما سيحدث من أحداث ومنعطفات كبيرة، ومما عمق من البنية الدرامية والتأطير السايكولوجي ارتكاز البنية السردية على تقنيّة أو أسلوب تعدّد الأصوات أو المنحى البوليفوني فكلّ شخصيّة قدّمت عالمها ودواخلها وصراعاتها الداخلية على الرغم من أن التركيز كان من حصّة الشخصيّة الرئيسية. وتواجهنا من الظواهر الفنيّة توافر الإيقاع السردي السريع، ومحاولة الإسراع بالأحداث وصولاً إلى النهاية الدالّة والكاشفة عن المعنى الكلّي الذي تمركز حوله الخطاب الروائي بشكل عام، ولذلك لجأ الكاتب الى تقنيات تسريع الايقاع السردي مثل الحذف والاختصار، وسرعة الانتقالات والميل إلى التجسيد البانورامي وتحقيق نوع من التحوّل من مكان إلى آخر على الرغم من أن بغداد، والموصل والعمارة هي الأمكنة التي احتضنت بيئة الأحداث. ومن الظواهر الفنيّة الأخرى التضمين الفكري للرواية فقد تجلّى هذا المنحى بتوظيف التاريخ في الرواية لاسيما الإشارات والتفاصيل المتعلّقة والمختزلة حول أحداث مثل (ثورة مايس 1941) ضد النظام الملكي و(ظاهر الفرهود) التي طالت طائفة اليهود وأحداث تهجير اليهود عامي 1949، 1950، وأحداث ثورة تموز 1958 واعقبه انقلاب شباط 1963، ووثقت الرواية على وفق أسلوب أكثر تفصيلاً حين تصدّت وكشفت كواليس ومظاهر التجلّيات الرثّة لمرحلة هجوم واحتلال داعش والقوى التكفيريّة في الموصل عام 2014، ولم يطلق الكاتب على الدواعش إلاّ بوصفهم (الصراصير) كناية عن فكرهم الرثّ وطقوسهم البذيئة وأساليبهم المتوحشة والظلامية، ولعلّ من أهم الأحداث التاريخية التي وثقتها وتعمّقت في أجوائها الرواية هي أحداث الإنتفاضة التشرينية عام 2019 في بغداد، وتصوير الأحداث قرب المطعم التركي، وساحة ونصب التحرير، والجسور والأزقّة القريبة التي شهدت المواجهات بين المتظاهرين والمتصدّين وبين أجهزة السلطة والدولة آنذاك بكلّ قسوتها وأسلحتها الدخانية، وقد اكتسبت الأحداث التاريخية دلالة عميقة للكشف عن المنعطفات التي استهدفت الشعب بمختلف أطيافه والأحداث التي حاولت كسر التناغم والتآصر المكوّناتي والإنساني، ولذا اكتسب توظيف التاريخ في الرواية بُعداً واقعيّاً ورمزيّاً، والرواية عموماً اشتغلت على مستوى الدلالة بين الواقعي والرمزي، وكشفت عن نسقها الإنساني في النظر إلى الواقع والتاريخ على وفق منظور يضع الإنسان والإنسانيّة في موضع الرصد واكتشاف المعنى وحالة الضعف والإنبثاق في هذه الدوّامة من الأحداث والدلالات. وتبدو حياة البطل أو سيرة (آدم) قد ارتبطت بوجود فكرة الرحلة على مستوى التفكير والبحث عن الحقيقة أو فكرة الإرتحال بمعناه المكاني ورحلته مع عمّه المطران إلى الموصل، وأهم أحداث الرحلة إلى الموصل أنه لم يجد ذاته في الطقوس الكنائسية، وبدأ يبحث عن الحقيقة حتى التقى بشخصيّة الدرويش الذي وجد فيه الملاذ الروحي والصوفي الحقيقي، وتلك دلالة رمزيّة وتأويلية أن الفكر الإنسانيّ اليقيني يلتقي ويتفاعل على الرغم من اختلاف أساليب وطقوس التديّن المختلفة ويمثّل المقطع الآتي تجلّياً لهذا النمط من التفكير المتعالي والمتناغم: "ردّ عليّ التحيّة بإيماءة من سبابته مع اهتزاز رأسه وهو منشغل بزر زيق دشداشته وترتيب جلسته سألته مبتسماً:
أجابني وهو ما زال مطرقاً رأسه إلى الأرض:
اجابني بسؤال ساخر:
ثم أردف قائلاً:
ولعلّ من الشخصيات الدالّة والمهمة في الرواية فضلاً عن شخصيّة الدرويش هي شخصيّة (سعدة) وهي معلّمة تنتمي إلى الطائفة اليهودية ترفض التهجير أو التوجّه إلى اسرائيل، وتتزوج مسلماً وتعلن إسلامها، ولكن على الرغم من هذا فإنّ الحملة السلطوية ضدّ الأقليات أجبرتها على النزوح إلى تركيا، والذهاب إلى إسرائيل وتلك دلالة على الاستبداد والقمع ضدّ الإنسان وبمختلف الأديان فالإستبداد يتمركز حول الآيديولوجيا وغالباً ما تكشف الآيديولوجيات عن تمركز براغماتي ونفعي وشعاراتي، ومن الدلالات الرمزية في الرواية لجوء (آدم) إلى الجبل مع كثير من الناس هرباً من وحشية وبدائية الدواعش أو القوى الظلاميّة، فالجبل هو العاصم وهو الملاذ والسمو عن الأفكار الضالّة والنيّات المعتمة ويمثل الجبل دالّة رمزيّة للملاذ والخلاص بعد أن فقد (آدم) رفيقه الإنساني (الدرويش) وقبل ذلك فقد حبيبته (حواء): "رجعتُ إلى مكمني في الجبل، وقد تدهورتْ صحتي بعد أن فقدت الحبيبة والنديم، لم أعد قادراً على النزول مرة أخرى إلى المدينة، وتقصّي حقائق خرابها، لأول مرّة انتبه بصورة فاحصة إلى الجموع الهاربة إلى قمة الجبل، أطفال ونساء وشيوخ وشباب من مختلف القوميّات والأديان، ولم أكن قد انتبهت إلى معاناة هؤلاء الناس أو لاحظت طوال مدّة هروبي إلى الجبل هذه السيول البشرية النازحة..." (الرواية: 67). وتواجهنا من الدلالات الرمزية على مستوى الأسماء ما تحمله دلالة العاشقين (آدم) و (حواء) وهي إشارة إلى الجذر والمعنى الإنساني بعيداً عن الهويات والتوصيفات الأخرى التي تمثلّ نوعاً من الإنغلاق والانكفاء، وتجسّد التسمية الثنائية (آدم/ حواء) العودة إلى الخليقة الأولى قبل ظهور الأديان وقبل كل المسميات والقوميات والمذاهب، فالإنسان قبل أن ينتمي إلى الأديان الثلاثة ينتمي بالأساس إلى دين الإنسانية والوجود التطهرّي الخالي من الرداء والعلامة والطقوس والتوجه، فهما الإنسان في كل زمان ومكان. ولعلّ أهم مأثرة واشتغال انساني وفني هو جمع الشخصيّات الثلاث: (آدم) و (حواء) و (سعدة) باللقاء الذي تم بينهم على شكل مصادفة وجوديّة واشارة وترميز دلالي حيث التقوا وجهاً لوجه في خضم التظاهرة التشرينية، ويدهش آدم بملاقاته بـ(حواء) وهي ترسم صورة أخيها الذي استشهد في انتفاضة تشرين، وتصبغ ألوان ملامحه على جدران نفق التحرير المكتظ بعشرات الآلاف وهم يهتفون ضد الطبقة السياسية الفاسدة، وضد أجهزة القمع التي تترصّدهم بالهروات والرصاص وقنابر الدخان، ويلمح من بعيد (سعدة) التي عادت إلى العراق وشاركت في هذه الانتفاضة الوطنية والإنسانيّة وذكرّها بأنّه ابن (جانيت) التي كانت معها في العمارة: "صعقت من هول المفاجأة وقد ارتسمت خيوط واهنة تحت عينيها، قالت بصوت عالٍ وتُلعثمت في حنجرتها حروف الكلمة: من أنت؟
قلت ذلك وأنا أنحني على يديها أقبلّهما. بين الكر والفر لاح لي (الدرويش) شامخاً وسط الجسر وهو يلّوح بعصاه... ازداد سواد الدخان وتصاعد أزيز الرصاص، وتهدّمت الخيام.. والدائرات حولنا لن تنضب.. اصطحبنا أنا وحواء الست سعدة مع السيل الجارف المتجّه إلى شارع الجمهوريّة صوت ساحة الخلاّني، ونحن نطوقها بذراعينا لنسند جسدها الضعيف بعد أن تزاحمت غيوم الدخان في ساحة التحرير". (الرواية: 86- 87). تكمن براعة الكاتب عبد الزهرة علي في خلق دلالة رمزيّة أفضت بمخيّلته أن يستعيد الشخصيّات التي تفرقّت، ويعيد استحضارها في مشهد الانتفاضة التشرينية بعد أن اعتقد الجميع بأنّ لا لقاء سيجمعهم إلاّ بمعجزة، والانتفاضة هي نوع من المعجزة والكفاح ضد التسلّط والظلم والجور وقسوة الواقع الفاسد. ولعلّ جمع المثلّث الذي يمثل الشخصيّات الرئيسية والمركزية (آدم وحواء وسعدة) له دلالات رمزيّة عالية وشفيفة، أي اجتماع المسلم والمسيحي واليهودي المهجّر والتمسّك بعراقيته، وهذا الهرم الثلاثي يمثّل الأديان الثلاثة بأفقها ومعناها الإنساني بعيداً عن القبح والتطرّف والإنغلاق الكهنوتي، وهو بديل للأقانيم الثلاثة، بمعنى أن هذا المثلث هو الأقنوم الإنسانيّ الذي يتربّع فوق كلّ الديانات والقوميات والمذاهب والهويّات والإنتماءات الضيّقة، فالدين الإنسانيّ كما هي الأوطان تستوعب وتحتضن الجميع بلا تمييز أو تعصّب أو محو الآخر أو عدم قبوله، وعلى الرغم من موت (سعدة) وإصابة حواء المميتة فإن رمزية المشهد قد عبرّت عن هذا التوّجه وقيمته السامية في بعده الإنسانيّ. وتعدّ رواية (اخترت إلها) تجربة تستحق الإشادة لما عبرت عنه من توّجه إنساني رفيع وتنويري ونبذ لكلّ أشكال الفكر الظلامي وتداعياته المعتمة وامتازت باشتراطات وظواهر البناء الفني الذي جسّد هذه الثيمات العميقة والدالّة، إنها عمل مختلف عمّا كتبه عبد الزهرة لما فيها من تحوّل نوعي. |
| المشـاهدات 273 تاريخ الإضافـة 08/02/2025 رقم المحتوى 59001 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة |
 إدانة الحرب والقبح
في رواية (وكر السلمان) إدانة الحرب والقبح
في رواية (وكر السلمان) |
 |
 اقتصادٌ مُنهك يبحث عن إدارة رشيدة: قراءة في أزمات العراق المالية اقتصادٌ مُنهك يبحث عن إدارة رشيدة: قراءة في أزمات العراق المالية |
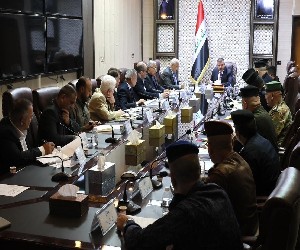 |
 أمانة بغداد تكشف استعداداتها المبكرة لمواجهة الأمطار
اجتماع موسع لمركز إدارة الأزمات والكوارث لمناقشة الاستعدادات للأمطار والسيول أمانة بغداد تكشف استعداداتها المبكرة لمواجهة الأمطار
اجتماع موسع لمركز إدارة الأزمات والكوارث لمناقشة الاستعدادات للأمطار والسيول |
 |
 فتح باب الترشح للإطار التنسيقي بين إملاءات الواقع وإرادة التغيير فتح باب الترشح للإطار التنسيقي بين إملاءات الواقع وإرادة التغيير
|
 |
 افتتاح معرض الواقعية السنوي في البصرة افتتاح معرض الواقعية السنوي في البصرة
|
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


