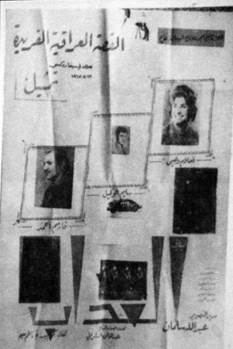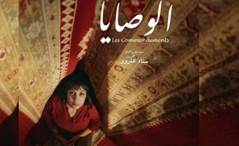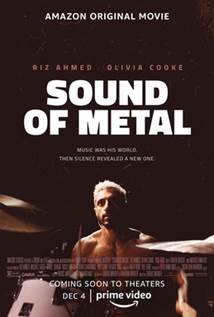الأطر الإدراكية في قصيدة " كحول المزرعة "
الأطر الإدراكية في قصيدة " كحول المزرعة "
 |
| الأطر الإدراكية في قصيدة " كحول المزرعة " |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
الدكتور عادل الثامري تمثل قصيدة "كحول المزرعة" للشاعر سالم محسن فضاءً إدراكياً مفتوحاً يعتمد على تداخل وكسر الأطر الإدراكية لخلق توترات ادراكية تدفع القارئ الى بناء المعنى وتفكيك الرموز باستمرار، اذ تعمل الاستعارات التصورية كجسور بين هذه الأطر من خلال تجسيد المفاهيم المجردة، مما يُشرك المتلقي في عملية إبداعية تفاعلية عبر الفجوات الدلالية والانتقالات المفاجئة بين المشاهد، متجاوزاً التلقي السلبي إلى المشاركة الفاعلة في إنتاج المعنى ضمن فضاء شعري غني بالتأويلات. الأطر الادراكية الأطر الإدراكية هي بنى معرفية منظمة تحتوي على معلومات نمطية عن مواقف أو أحداث متكررة في الحياة. تعمل هذه الأطر في النص الأدبي كمخططات ذهنية تساعد القارئ على تنظيم المعلومات وفهم تسلسل الأحداث وتوقع ما سيأتي. نجد في قصيدة "كحول المزرعة" للشاعر سالم محسن أطراً إدراكية متعددة متداخلة ومتكسرة، تخلق فضاءً شعرياً مركباً يتطلب من القارئ جهداً إدراكياً مضاعفاً لبناء المعنى. يتجلى إطار الاسترخاء والتأمل في مقاطع متعددة من النص أبرزها" إنَّ العشبَ الأخضرَ يُرِيح الجَسَدَ / ويَذهبُ بالخَيال أَيْنمَاَ يُرِيدُ" و "اِسترخِ / اِفتِحْ راحتيكْ، أغمِضْ عينيكَ، تنفَّسْ بعمقٍ وتصوَّرْ"و "إذا أحسسْتَ بالنّشوةِ فلتَتَمَدَّدْ على العَشَبِ". يؤسس هذا الإطار لفضاء التأمل والهدوء والاتصال بالطبيعة، لكنه لا يُترك ليكتمل، بل يُقطع ويُكسر باستمرار. يتناقض إطار الحرب والدمار مع إطار الاسترخاء السابق، حيث يظهر بقوة في مقاطع عديدة من القصيدة" قلْتُ: تَعالَ إلى القَصَفِ وارَعَ زُهُورَ القَذَائفِ وأَوْراقَ الشَظايا"و "البارِجةُ في هُدوءٍ من الأَمْوَاجِ تَّحْصِي الشَواطِئَ" و "كُنْ متحفّظاً في قيادةِ الجيوشِ "و"بريدُ الجَيشِ أوْقَفَني عندَ البابِ وقال: ألاَ انصرفْ". يستحضر الشاعر صورة القصف وزهور القذائف وأوراق الشظايا، ويصور البارجة التي تحصي الشواطئ في هدوء من الأمواج. كما يظهر حضور الجيش من خلال التحذير من قيادة الجيوش والإشارة إلى بريد الجيش الذي يمنع الدخول. يستحضر هذا الإطار فضاء العنف والصراع، مما يخلق تناقضاً حاداً مع إطار الاسترخاء والتأمل. يتجلى إطار العرس والاحتفال في مقطع واحد مركز يصور فيه الشاعر العريس الجالس على الكرسي بعد خروجه من الحمام، والقرى التي جاءت بالزوارق تطلق البوق والفانوس "جاءَ من الحمَّامِ، على الكُرسيِّ جَلَسَ العَريسُ / والقُرى جَاءتْ بالزَّوارقِ تُطلقُ البَوْقَ والفَانُوسَ / العُرْسُ يُوغِلُ فِي الشَّجَنِ، لنأخذَ بحديثِ المَزرَعةِ" ، لكن هذا الإطار سرعان ما يتحول من الفرح إلى الشجن، مما يكسر أفق توقع القارئ ويحول لحظة الفرح المفترضة إلى لحظة حزن وتأمل. ويتمظهر إطار المستشفى والمرض في مقاطع "صَباحَ الخيرِ قالَ الطَبيبُ / لقَدْ ضَجِرْتُ" و "تَشتدُّ الحياةُ وتَحتدُّ وتَطرحُ أَحْبابَها على أسرّةِ الرَدَهاتِ"و "تصور لقاء الطبيب الذي يبدأ بتحية صباح الخير ثم يعبر عن ضجره. كما يتجلى في وصف اشتداد الحياة واحتدادها وطرحها للأحباب على أسرة الردهات، مما يستحضر صورة المستشفى وحالة المرض والمعاناة. تعتمد القصيدة على استراتيجية كسر الأطر الإدراكية وتداخلها بطرق غير متوقعة، ما يخلق توتراً إدراكياً وحالة من الغموض المنتج. فالتداخل بين إطار الحرب وإطار الزراعة يظهر بوضوح في دعوة الشاعر للمخاطب أن يأتي إلى القصف ويرعى زهور القذائف وأوراق الشظايا، حيث تتحول أدوات الدمار إلى عناصر طبيعية قابلة للزراعة والرعاية. كما يكسر الشاعر إطار العرس التقليدي بوصفه بأنه يوغل في الشجن، محولاً الفرح المتوقع إلى حزن. ويتداخل إطار الاسترخاء مع إطار العنف في دعوة المخاطب إلى تذكر أصول الزراعة عند الشعور بالنشوة، مقترناً باسترخاء الجسد في سياق مليء بإشارات العنف. هذه الاستراتيجية تجعل القصيدة مفتوحة على تأويلات متعددة، وتتطلب من القارئ إعادة بناء المعنى باستمرار. الاستعارات التصورية تعمل الاستعارات التصورية في القصيدة كجسور بين الأطر الإدراكية المختلفة، وتساعد على تنظيم تجربة القارئ الإدراكية. تقوم هذه الاستعارات على ربط المجردات بالملموسات، مما يسهل على الذهن معالجتها وتخزينها. من أبرز الاستعارات التصورية في القصيدة استعارة "الحياة مسرح" التي تظهر بشكل متكرر في مقاطع مختلفة. فعبارات مثل "بأسرعِ ما يُمكنُ يُسدلُ السّتارُ" و "سَرعانَ ما يُسدَلُ السّتارُ، سَرعانَ ما يُسْدَلَ الستارُ" و "بالقُبُلاتِ يُسدَلُ السِّتارُ" تجعل الحياة مشهداً مسرحياً له بداية ونهاية، وتضفي على الأحداث طابع التمثيل والزوال. ان تكرار فكرة "إسدال الستار" يؤكد على حتمية النهاية وسرعتها، ويعكس رؤية الشاعر للحياة كمسرح يتغير فيه المشهد باستمرار وتنتهي فصوله بسرعة غير متوقعة. تظهر استعارة "الذكريات أشياء مادية" في مقاطع عديدة من القصيدة. فعبارة "زرعْنا ذِكْراكَ" تصور الذكرى كبذرة يمكن غرسها في التربة لتنمو وتتطور. وفي "طاردتُ الحارِسَ في المُحافَظاتِ البَعيدةِ" تتحول الذكرى إلى كائن يمكن مطاردته والإمساك به. وفي مقطع "بَعُدْتُ كثيراً / حتّى صُرْتُ أُفكِرُ، فِي.. لا.. لا.." يصور التذكر كمساحة مكانية يمكن الابتعاد عنها. هذا التصور المادي للذكريات يجسد تجربة التذكر ويمنحها بعداً مكانياً يجعلها أكثر ملموسية وقرباً من التجربة الإدراكية للقارئ. وتبرز استعارة "الزمن سائل" في عبارات مثل "يَمورُ السّائلُ الأَحْمَرُ تحتَ القاربِ" و"يَترقرقُ ماءُ الرّمادِ على مرأى من عينيَّ". هنا يتحول الزمن من مفهوم مجرد إلى سائل متحرك يمكن أن يكون أحمر (دموي) أو رمادي (حزين)، مما يربط مرور الزمن بمشاعر الألم والحزن ويمنحه بعداً عاطفياً وجسدياً. يشكل الجسد نقطة محورية في بناء الاستعارات التصورية في القصيدة. في مقطع "إنَّ العشبَ الأخضرَ يُرِيح الجَسَدَ" يصبح الجسد موقعاً للراحة والاسترخاء. وفي "على السَرِير أنا أُمرِّرُ شفتيَّ على هَوَاكَ" يتحول إلى موقع للتعبير عن المشاعر والرغبات. وفي "يَسقطُ الحائطُ عَنْ طولِ الجسد" و"تَدحرجْتُ مِنْ عَلَى السُّلّمِ" يصبح الجسد عرضة للأذى والسقوط. تستخدم القصيدة الجسد كمرجع إدراكي أساسي، وتربط من خلاله بين الأطر المختلفة: الحرب، الحب، المرض، الموت. هذا التجسيد يجعل التجربة الشعرية أكثر حيوية وقرباً من خبرة القارئ الإدراكية. التفاعل الإدراكي للقارئ تستخدم القصيدة آليات متعددة لإشراك القارئ إدراكياً وجعله مشاركاً فعلياً في بناء المعنى. تظهر الأوامر المباشرة في عبارات مثل "اِسترخِ" و"اِفتِحْ راحتيكْ" و"تنفَّسْ بعمقٍ"، حيث تدعو القارئ إلى تجربة جسدية مباشرة تنقله من موقع المتلقي السلبي إلى موقع الفاعل المشارك. كما يظهر الاستفهام في عبارات مثل "ماذا يفعلُ؟" و"هل كَنْتُ عَلَى صَوَابٍ؟"، مما يدفع القارئ إلى التفكير والبحث عن إجابات. ويتجلى التحول من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب في عبارة "إذا أحْسَسْتَ بالنَشْوَةِ فلتتَذكَّرْ مَعّي أُصولَ الزَرّاعةِ"، مما يخلق حالة من التداخل بين الذات الشاعرة والقارئ ويجعل التجربة الشعرية تجربة مشتركة. تعتمد القصيدة على خلق فجوات دلالية وغموض مقصود يتطلب من القارئ تفعيل قدراته الإدراكية لملئها. فالانتقالات المفاجئة بين المشاهد، كما في "البُرجُ والمَطَرُ والعائِلةُ / سِوىَ الهَياكَلِ / من كلِّ شيءٍ سِوىَ الهَياكلِ"، تترك فراغات تأويلية يملؤها القارئ برؤيته الخاصة. والجمل غير المكتملة، مثل "لَن يبقَى سوى"، تدفع القارئ إلى إكمال النقص وفق تصوره. والإشارات إلى شخصيات وأماكن غير مشروحة بالكامل، مثل "غاراسيا" و"سِجِلْماسَةُ" و"البُرج الصينيّ"، تفتح المجال لتأويلات متعددة. والتضارب بين المشاهد المختلفة، كالتناقض بين "اللَّبُؤَةُ الجَريحةُ تَزْحَفُ" و"فواخِتُ الحِنطةُ هادِئةٌ"، يخلق توتراً إدراكياً يستفز ذهن القارئ. والصور المتناقضة، مثل "صَرخةُ القطّةِ في ماكينةِ العَصيرِ" التي تجمع بين العنف والحياة اليومية، تدفع القارئ إلى البحث عن معنى يتجاوز الظاهر. هذه الفجوات تجعل القصيدة فضاءً مفتوحاً للتأويل، يتطلب من القارئ استخدام خبراته الإدراكية لبناء جسور بين العناصر المتباعدة، مما يحول القراءة إلى عملية إبداعية نشطة تتجاوز مجرد التلقي. تتميز القصيدة بالانتقالات السريعة والمفاجئة بين المشاهد المختلفة، فمن مشهد الاسترخاء على العشب تنتقل فجأة إلى مشهد قابيل وفرائضه، ومن مشهد البارجة العسكرية إلى مشهد الجثة الملفوفة بالكفن، ومن مشهد المكالمة الهاتفية عن القطة وماكينة العصير إلى مشهد الليل والمطاعم. هذه الانتقالات تعمل على إثارة الانتباه الإدراكي للقارئ، وتدفعه إلى البحث المستمر عن روابط ممكنة بين هذه المشاهد المتباعدة. كما أنها تخلق إيقاعاً ذهنياً متوتراً يعكس حالة الاضطراب والتشتت التي تسيطر على القصيدة. وتفرض بنية القصيدة المتشظية والمتداخلة على القارئ أن يتبنى استراتيجية قراءة غير خطية. فالقارئ يجد نفسه مضطراً إلى التقدم والتراجع في النص للربط بين العناصر المتباعدة، وتفعيل الذاكرة لاستدعاء صور وأطر سابقة في القصيدة، والبحث عن أنماط متكررة تمنح النص تماسكه مثل تكرار عبارة "يُسدَلُ السّتارُ"، والتأرجح بين الفهم الحرفي والفهم الاستعاري للصور الشعرية. هذه العمليات الإدراكية المعقدة تجعل قراءة القصيدة تجربة إبداعية تفاعلية، يشارك فيها القارئ بفاعلية في إنتاج المعنى. |
| المشـاهدات 293 تاريخ الإضافـة 03/05/2025 رقم المحتوى 62445 |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد