 ماكس هوركهايمر و بنية النقد
ماكس هوركهايمر و بنية النقد
 |
| ماكس هوركهايمر و بنية النقد |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الدكتور عادل الثامري الكاتب الدكتور عادل الثامري |
| النـص :
مقدمة في مقاله "الهجوم الأخير على الميتافيزيقا"، يقدّم ماكس هوركهايمر تصريحًا أصبح من العبارات المفتاحية في الفكر النقدي: "حين يُدرك فرد نشط ذو حسّ سليم الحالة البائسة للعالم، تصبح الرغبة في تغييره المبدأ الموجّه الذي ينظم به الحقائق المعطاة ويشكّلها في نظرية." لا تكتفي هذه العبارة بوظيفة منهجية، بل تقدّم تكثيفًا نظريًا للإحداثيات الوجودية والمعرفية والمعيارية التي يُبنى النقد ضمنها. فهي تفتح مدخلًا مباشرًا إلى الحقل المفاهيمي للنقد، مبيّنة كيف يصبح الوعي بالبؤس نقطة انطلاق لتحريك الرغبة في التغيير، وكيف تتحول هذه الرغبة إلى مبدأ يوجّه تنظيم الوقائع ضمن إطار نظري نقدي. لا ينصبّ الاهتمام هنا على وضع هذا التصريح ضمن المسار الأوسع لفكر هوركهايمر أو داخل مشروع مدرسة فرانكفورت بوجه عام، بل يتركّز على العبارة نفسها، بوصفها مفتاحًا لتوضيح العناصر الأساسية التي تجعل النقد ممكنًا وضروريًا، مع إبراز الروابط المنطقية التي تصل بين الوعي بالبؤس والرغبة في تغييره وتنظيم المعرفة حوله. فالتوجّه داخل الفضاء المفاهيمي للنقد ليس لحظة فورية، بل عملية ممتدة تتطلب التكرار وتراكم الخبرة وصقل القدرة على تمييز الجوهري من العَرَضي. وبهذا المعنى، يقدّم تصريح هوركهايمر بنية منطقية للنقد تبدأ بافتراض وجود العالم ككيان محدد، يتبعه تشخيص حالته كبؤس، وإمكانية إدراك هذا البؤس من قِبل الفاعل النشط، مما يولّد رغبة في تغييره، قبل أن تتحول هذه الرغبة إلى مبدأ ينظم الوقائع ضمن نظرية نقدية. من خلال هذا التسلسل، يتكشّف النقد كممارسة جدلية تتداخل فيها الأنطولوجيا والمعيارية والمعرفة والعاطفة والممارسة في نسيج واحد، مشكّلة خريطة مركّزة لبنية النقد وإمكاناته. الشروط الأنطولوجية للنقد تفترض المقولة الأولى وجود عالم معطى سابق على وعينا وتأويلاتنا، وهو افتراض لا يمكن اعتباره بديهيًا أو تافهًا في سياق النقاشات الفلسفية الحديثة، بل يمثل حجر الأساس الذي يُبنى عليه إمكان النقد ذاته. فلو كان العالم مجرد بناء لغوي أو تأويلي بلا أي مقاومة مادية أو موضوعية، لفقد النقد موضوعه، ولما كان هناك معنى للحديث عن بنى اجتماعية واقتصادية وسياسية قابلة للفحص والتحليل والمراجعة. إن الإقرار بوجود عالم مستقل يحمل أبعادًا مادية وتاريخية واجتماعية هو ما يسمح للنقد بالتوجه نحو الخارج، والانخراط في محاججة واقعية مع الشروط القائمة بدل الانغلاق في لعبة لغوية أو تأويلية صرفة. ومع ذلك، فإن هذا العالم لا يُعطى لنا بوصفه معطًى محايدًا أو ثابتًا، بل يأتي مطبوعًا بترسبات التاريخ، وبالعلاقات الاجتماعية، ومحددًا بالمؤسسات والبنى الاقتصادية والسياسية والثقافية. بهذا المعنى، فإن كل تأمل نقدي جاد يستلزم طرح أسئلة حول كيفية تشكّل هذه الشروط، وما الذي يمنحها طابع الثبات الظاهري، وكيف يمكن زعزعتها وإعادة تشكيلها. البعد المعياري أما المقولة الثانية، فهي تنقلنا من الوجود إلى المعيارية عبر تشخيص حالة العالم كبؤس وانحطاط، وهو تشخيص لا يُفهم كموقف ذاتي أو تعبير انفعالي، بل كتحديد معياري يستند إلى معايير ضمنية أو صريحة عن العدالة والكرامة الإنسانية والرفاه وتقليل المعاناة. إن توصيف حالة العالم بالبؤس يعني أننا نمتلك أدوات للتقييم، وأن هناك قيمًا ومبادئ يمكننا بواسطتها قياس مدى اقتراب الواقع منها أو انحرافه عنها. ويشير "البؤس" هنا إلى تشابك أشكال متعددة من العنف: البنيوي والرمزي والاقتصادي والبيئي، بما يكشف عن طبيعة العالم الراهن بوصفه عالمًا مفعمًا بالتفاوتات والاغتراب والانتهاكات. من خلال هذا التشخيص، يصبح النقد ممكنًا لأنه يستند إلى مفارقة أساسية: وجود معايير للعدالة والكرامة تقابل واقعًا يعجز عن تحقيقها أو يخونها بشكل منهجي. وبهذا المعنى، يصبح النقد دعوة مستمرة لردم الهوة بين المأمول والقائم. إمكانية النفاذ المعرفي تُبرز المقولة الثالثة بُعدًا أساسيًا في النقد يتمثل في إمكانية النفاذ المعرفي إلى الشروط البائسة للعالم. فالإقرار بأن "فردًا نشطًا ذا حسّ سليم" قادر على إدراك بؤس العالم يحمل في طياته قناعة بأن الواقع ليس غامضًا على نحو مطلق، وأن فهم بنياته وظروفه ممكن من حيث المبدأ دون حاجة إلى احتكار معرفي أو امتلاك نوع من البصيرة الغامضة. هنا يظهر البعد الديمقراطي للنقد: الوعي بالظلم والانحطاط لا يقتصر على النخب الأكاديمية أو الفئات المثقفة وحدها، بل هو في متناول الأفراد الذين يملكون حدًا أدنى من الحس النقدي والقدرة على التمييز بين العادل والظالم. كما تشير عبارة "الفرد النشط" إلى أن النقد ليس مجرد معرفة محايدة، بل يتطلب نوعًا من الفاعلية؛ فالإدراك الذي لا يتحول إلى فعل يظل ناقصًا أو معلقًا. النقد هنا ممارسة للفاعلية، إذ تتحول المعرفة إلى التزام ومسؤولية تجاه ما يدركه الفرد من مظاهر الظلم والمعاناة، فتولد فيه الاستعداد للتدخل والمساهمة في التغيير. الرغبة كقوة دافعة تنتقل المقولة الرابعة إلى محور الانفعال والرغبة بوصفهما محركين للنقد، إذ لا يكفي الإدراك العقلي لحالة البؤس كي يتحول النقد إلى ممارسة حقيقية، بل يتطلب الأمر تولد شحنة عاطفية ودافعية تتمثل في السخط أو الاستياء أو التوق إلى واقع بديل. فالرغبة هنا ليست إضافة عرضية، بل عنصر بنيوي في عملية النقد؛ إذ من دون هذه اللحظة الانفعالية، يمكن للمعرفة النقدية أن تتحول إلى موقف ساخر أو إلى حالة استسلام سلبي أمام بؤس الواقع. إن الانفعال الناتج عن إدراك الظلم والمعاناة يشحن النقد بطاقة قادرة على دفعه نحو الفعل، إذ يصبح النقد حينها أداة تشخيصية وتحويلية في آن، تربط بين الوعي النقدي والرغبة في التغيير والفعل العملي الهادف إلى إحداث تحول في العالم. بهذا المعنى، تتحول الرغبة من مجرد انفعال فردي إلى قوة محركة للنقد، تسعى إلى كسر الثبات الظاهري للعالم والانخراط في عملية تحويل مستمر. خاتمة تتيح لنا عبارة هوركهايمر استخلاص سلسلة منطقية تُنظم بنية النقد وتؤطر إمكاناته: يبدأ النقد من افتراض أنطولوجي أساسي مفاده أنّ للعالم وجودًا قائمًا يمكن تحديده وتحليله، يليه تشخيص معياري يرى في هذا الوجود حالة بائسة ومنحطة تتسم بالتفاوتات والظلم والاغتراب، ثم يأتي البعد المعرفي ليؤكد أن هذه الحالة البائسة قابلة للإدراك من قبل الذوات النشطة التي تمتلك حدًا أدنى من الحس النقدي. ومن هذا الإدراك ينبثق دافع عاطفي يتمثل في الرغبة في التغيير، وهي الرغبة التي لا تبقى مجرد انفعال عابر، بل تتحول إلى مبدأ مُنظِّم يعيد ترتيب الوقائع ضمن إطار نظري نقدي. بهذه الطريقة، يتجاوز النقد كونه جهدًا معرفيًا معزولًا أو استجابة انفعالية لحظية، ليظهر كممارسة جدلية متكاملة تتداخل فيها المعرفة والعاطفة والمعيارية في نسيج واحد. وتصبح الممارسة النقدية هنا أداة تشخيصية وتحويلية في آن، تُعيننا على فهم الواقع بعمق وفي الوقت نفسه تحفزنا على تغييره. وهكذا، يكشف تصريح هوركهايمر عن النقد بوصفه شكلًا من أشكال الالتزام المزدوج: التزام بالفهم الجاد للعالم بما هو عليه، والتزام بالرغبة والسعي نحو عالم أفضل، ليبقى النقد فعلًا حيًا ومفتوحًا في قلب الممارسة الفكرية والاجتماعية معا. |
| المشـاهدات 181 تاريخ الإضافـة 23/07/2025 رقم المحتوى 65030 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة |
 السوداني يستعرض نتائج زيارته الرسمية الى مقر حلف شمال الاطلسي
الحكومة تقر مشاريع للطاقة والبنية والتعليم والدفاع والتحول الرقمي السوداني يستعرض نتائج زيارته الرسمية الى مقر حلف شمال الاطلسي
الحكومة تقر مشاريع للطاقة والبنية والتعليم والدفاع والتحول الرقمي |
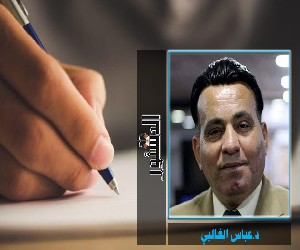 |
 بنية السياحة في العراق بنية السياحة في العراق
|
 |
 المستقبل يبدأ من بغداد تأسيس بنية رقمية موحدة المستقبل يبدأ من بغداد تأسيس بنية رقمية موحدة
|
 |
 الشركة الصينية بدأت بناء البنية التحتية للمشروع
باشرت بأحدهما.. أمانة بغداد تعلن تفاصيل مشروعين لتحويل النفايات لطاقة كهربائية بالعاصمة الشركة الصينية بدأت بناء البنية التحتية للمشروع
باشرت بأحدهما.. أمانة بغداد تعلن تفاصيل مشروعين لتحويل النفايات لطاقة كهربائية بالعاصمة |
 |
 أبو رغيف يشدد على تطوير البنية التحتية للاتصالات في كربلاء لاسيما في المناسبات الكبرى أبو رغيف يشدد على تطوير البنية التحتية للاتصالات في كربلاء لاسيما في المناسبات الكبرى |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


