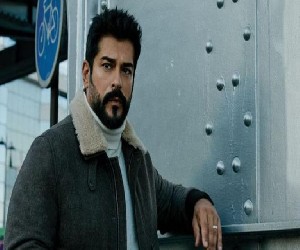القيادة فرز أم اختيار أم تكليف؟ تماهيات في معنى القائد
القيادة فرز أم اختيار أم تكليف؟ تماهيات في معنى القائد
 |
| القيادة فرز أم اختيار أم تكليف؟ تماهيات في معنى القائد |
  
|
 كتاب الدستور كتاب الدستور |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب سالم رحيم عبد الحسن الكاتب سالم رحيم عبد الحسن |
| النـص :
لطالما شغلت القيادة موقعًا محوريًا في تشكيل مسارات المجتمعات وتوجيهها، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الفكري. فمنذ فجر الحضارات، تساءل الإنسان عن مصدر شرعية القائد: هل هو شخص يُفْرز طبيعيًا نتيجة امتلاكه صفات استثنائية؟ أم يُختار بإرادة جماعية تعبّر عن وعي جمعي؟ أم يُكَلَّف بمهمة القيادة من قبل سلطة أعلى، دينية كانت أو مؤسسية؟ هذه التساؤلات، وإن بدت بسيطة في ظاهرها، فإنها تنطوي على تماهيات عميقة بين المفهوم والشخص، بين الوظيفة والدور، وبين الفعل والرمز. فالقائد في مخيال الشعوب ليس مجرد فردٍ يؤدي دورًا؛ بل قد يغدو رمزًا تُعلَّق عليه الآمال، وتُسقَط عليه الرغبات الجماعية.يرى كثير من المفكرين أن القائد لا يُصنع ولا يُعَيَّن، بل يُفْرز من بين الناس بوصفه استثناءً. في هذا التصور، القيادة ليست منصبًا يُمنح، بل نتيجة منطقية لتفوق الفرد على محيطه في صفات أساسية، مثل الحضور الشخصي أو الكاريزما، الذكاء العملي، القدرة على اتخاذ القرار، وامتلاك رؤية مستقبلية تتجاوز اللحظة الآنية. لكن هذا النموذج يطرح تساؤلات حول العدالة، وموقع البيئة والظروف في "فرز" القائد، مما يجعلنا نتساءل: هل القيادة حقًا صفة فطرية؟ أم أنها نتاج تراكب معقّد لعوامل فردية وظرفية؟في المقابل، تُقدَّم القيادة في النظم الحديثة كفعل اختياري ينبثق من الإرادة الجماعية. في هذا النموذج، تُبنى شرعية القائد على أسس مثل الثقة، والمساءلة، والتمثيل، وغالبًا ما تُفعَّل عبر آليات ديمقراطية. لكنّ هذا النموذج، على جاذبيته النظرية، يواجه تحديات عملية كبيرة: - اختيار غير الأكفّاء تحت تأثير الإعلام أو المشاعر، - تحوّل القائد إلى مجرد "واجهة" بلا صلاحيات حقيقية، - ضعف ثقافة الانتخاب الواعي في بعض المجتمعات، مما يجعل الديمقراطية شكلًا بلا مضمون. أما في السياقات السلطوية أو الدينية، فإن القيادة تُفهم غالبًا بوصفها تكليفًا من جهة عليا. في هذا النموذج، يستمد القائد شرعيته لا من الجماعة، بل من سلطة أعلى، سواء كانت مؤسسية أو دينية أو رمزية. وهذا ما يطرح إشكالية العلاقة بين "القبول الجماهيري" و"المشروعية المفروضة". في هذا السياق بالذات، قدّم السيد الشهيد محمد باقر الصدر رؤيته العميقة في مفهوم "قيادة الأمة"، مؤكدًا أن القيادة ليست سلطة تُمارس على الناس، بل أمانة تُحمل عن وعي ومسؤولية، تستلزم البصيرة بالدين، والإلمام بقضايا الزمان، والالتصاق بالناس. وفي رؤيته، القائد ليس من ينطق باسم الدين فقط، بل من يطبّقه بصورة عقلانية وعدلية في واقع الحياة، متجاوزًا الجمود، ومتحررًا من المصالح الضيقة. وقد طوّر هذا المفهوم لاحقًا السيد محمد باقر الحكيم، الذي رأى أن القيادة الحقيقية في زمن الدولة الحديثة لا يمكن أن تستند إلى الورع الشخصي فحسب، بل يجب أن تتجسّد ضمن مرجعية سياسية تتماهى مع المرجعية الدينية، لتحقيق توازن بين المبدأ والتطبيق، وبين الشريعة والحكم. وقد جسّد هذا الاتجاه في ممارساته بعد 2003، داعيًا إلى قيادة دينية مسؤولة تمثل الشعب وتؤسس لمجتمع مدني عادل يسترشد بالقيم.ومن أبرز ملامح مشروع القيادالمؤسسية عند الشهيدين الصدر والحكيم، هو دعوتهما الصريحة إلى مأسسة الحوزة العلمية، من خلال تأسيس مجمع فقهي يضم كبار المجتهدين، مهمته توحيد الرؤية الفقهية وتقليل التشتت في الفتوى. ولم يكن هدف هذه الدعوة فرض الرأي الواحد، بل إنشاء مرجعية جماعية تتفاعل بمرونة مع تحديات العصر، وتمنح القرار الفقهي والمجتمعي صبغة مؤسسية. إن مثل هذا المجمع كان يُنظر إليه كبنية ضامنة لتكامل المعرفة، وتوزيع المسؤوليات، وتحصين المرجعية من الفردية أو التأثر بالاستقطابات.ورغم عمق هذه الرؤى، برزت أزمة القيادة بعد سقوط النظام في العراق عام 2003، حين فشلت الحركات الإسلامية في إنتاج "القائد الجامع". توزعت الشرعيات، وتكاثرت المرجعيات، وغاب المشروع الموحد. وبرزت القيادات الفئوية التي تُمثل جماعة دون أخرى، أو تيارًا دون بقية الأمة. كانت هناك محاولات لإنتاج شخصية قائدة تجمع بين العمق الديني والخبرة السياسية والقبول الاجتماعي، لكنها لم تنجح، مما ولّد فراغًا رمزيًا وسياسيًا كبيرًا. في المقابل، تقدّم تجربة السيد روح الله الخميني نموذجًا نادرًا لقائد جمع بين المرجعية الدينية والقيادة السياسية، دون أن يجعل من ذلك مشروعًا شخصيًا أو عائليًا. استطاع الخميني أن يوحّد الصفوف، ويُلهِم الجماهير، ويؤسس دولة بمشروع روحي وأخلاقي، ولم يستخدم منصبه لجني مكاسب ضيقة أو لتوريث القيادة. تميّز بالزهد في المنصب، والصرامة في الموقف، والتوازن بين الرمز والواقع، مما جعله نموذجًا فريدًا في القيادة الإسلامية الحديثة.ومع تحولات العصر الرقمي، لم تعد القيادة حكرًا على الساسة أو العلماء. صار المؤثّر الرقمي قادرًا على تعبئة الرأي العام، وصار صانع المحتوى منافسًا للمنظر السياسي. لكن هذا التوسع في أدوات التأثير جاء على حساب العمق، حيث طغت الصورة على الفكرة، وساد الانفعال على التحليل.اليوم، نشهد فوضى رمزية: وجوه كثيرة، لكن مشاريع قليلة. خطابات متعددة، لكن بوصلة غائبة. وكل ذلك يجعل الحاجة إلى قيادة رشيدة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.فالقيادة لا تكتمل إلا حين يلتقي: - الاستحقاق الشخصي (فرز)، - بالقبول الجماعي (اختيار)، - وبالتكليف الواعي (مسؤولية). القائد ليس من يعلو الناس، بل من يحملهم معه. ليس من يتسلّق على أكتافهم، بل من يسندهم حين يتعبون. ليس من يدّعي العصمة، بل من يعترف بالخطأ ويتعلم.وفي زمن الانقسام والضياع، ما أحوجنا إلى قيادة تحمل المعنى لا المجد، وتُعيد بناء الثقة بين الناس، والمبدأ، والمصير. |
| المشـاهدات 24 تاريخ الإضافـة 19/10/2025 رقم المحتوى 67495 |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد