| النـص :
حسونة المصباحي
عوّدنا الفنان التونسي الكبير فاضل الجزيري بأن يُتحف عشاق الفن والثقافة بالمفاجآت التي تُنهي الكساد والجمود، وتأتي بما يُعيد للنفوس إشراقة الأمل. كما عوّدهم بأنه يرفض الالتزام بنوع فني معيّن، بل يحب أن يتنقل بخفة ويُسر بين مختلف أشكال الفنون. فهو الممثل اللامع في مسرحية "غسّالة النوادر" الشهيرة، والمشارك في كتابتها مع رفاقه الذين احتضنتهم فرقة "المسرح الجديد"، والتي عُرضت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي لتنفض الغبار الكثيف الذي غطى سنوات السبعين، أو "سنوات الجمر" كما يسمّيها من احترقوا بها، وكانوا من ضحايا عمليات القمع والتعسّف التي طبعتها.وهو المخرج المتميز لفيلم "ثلاثون" الذي يرسم صورة بديعة عن جيل الثلاثينيات من القرن الماضي... أي جيل الشابي والطاهر الحداد وجماعة "تحت السور" الذي انفتح على الحداثة الغربية، وتمرد على الأساليب الجامدة في الأدب وفي مختلف الفنون الأخرى، محاربًا التزمت والانغلاق في الثقافة والفكر، وممجدًا الحرية التي من دونها لا يكون للحياة معنى. وهو الذي أعاد للفنون الشعبية، وللأناشيد الدينية إشراقتها وجمالها مقدمًا إياها ضمن عروض فنية واحتفالية ضخمة مثل "الحضرة"، و"النوبة"، و"المحفل". وقد نالت تلك العروض إعجاب وتقدير الملايين، وترسّخت في ذاكرة التونسيين لأنها عمّقت شعورهم بهويتهم، ومعرفتهم بتاريخهم المهمّش والمهمل في زمن "الحداثة المعطوبة" بحسب عبارة للشاعر والناقد المغربي محمد بنيس. وبفضل هذا الحصاد الغزير، أهدى فاضل الجزيري لنفسه ولعشاقه مكانة بارزة في التاريخ التونسي الفني والثقافي منذ الستينيات من القرن الماضي وحتى هذه الساعة. وتأتي مسرحيته الجديدة "جرانتي العزيزة" (الجرانة هي الكمنجة باللهجة التونسية) لتزيدنا اقتناعًا بأنه لا يزال يتمتع بحيوية الشاب الذي كان، وبخياله الخلاق، وبقدرته الفائقة على أن يجعل الفن الوسيلة الأمثل لمواجهة مشهد فني كئيب ورتيب، ولقراءة جديدة للتاريخ الثقافي في تونس على مدى الستين سنة الماضية بكل ما فيه من عثرات وخيبات وإخفاقات، ومن إشراقات ونجاحات ومباهج ومسرّات...وفي هذه المسرحية التي يستغرق عرضها حوالي ساعتين، اختار الجزيري أن يكون الديكور "فقيرًا" مقتصرًا على بضعة كراسٍ فقط، وعلى خمسة ممثلين بينهم عازف الكمنجة وزوجته التي رافقت مسيرته الفنية على مدى عقود، والراوي الذي قد يكون فاضل الجزيري نفسه.وكان أداء الممثلين رائعًا من البداية إلى النهاية. ونجحت النجمة الصاعدة إشراق مطر التي لعبت دور الزوجة في أداء دورها بشكل بديع. لذلك يُصفّق لها الجمهور استحسانًا بين وقت وآخر خصوصًا عندما تردد أغاني تونسية أو عربية... وقد تخللت المسرحية فقرات موسيقية تونسية وعربية وأجنبية ليكون للموسيقى حضور قوي منذ البداية... وتنتهي المسرحية برقصة رائعة يؤديها أحد الممثلين على أنغام أغنية "خالي بدّلني" للفنانة الكبيرة صليحة التي كانت نجمة الغناء التونسي الأصيل في المرحلة التي سبقت حصول تونس على استقلالها...من خلال عازف الكمنجة، والراوي الأعمى، تستعرض المسرحية مراحل مفصليّة في التاريخ التونسي الثقافي والفني. والمرحلة الأولى هي بناء الدولة الوطنية بعد حصول تونس على استقلالها سنة 1956. وكانت الثقافة من بين الأركان التي اهتم بها الزعيم بورقيبة إلى جانب التعليم، والصحة، وحقوق المرأة. لذلك أُعيد الاعتبار لمبدعين ومثقفين أُهملوا وتم تهميشهم في المرحلة الاستعمارية مثل أبي القاسم الشابي، والطاهر الحداد، وجماعة "تحت السور" الذين تركوا المدارس قبل أن "تُبلى سراويلهم" لكي يلعبوا دورًا أساسيًا في تحديث الثقافة التونسية نثرًا وشعرًا وموسيقى ومسرحًا، وغير ذلك. كما اهتم نظام بورقيبة بالموسيقى من خلال فرقة الإذاعة التي أشرف عليها فنانون أفذاذ من أمثال عبد الحميد بن علجية، وأحمد عاشور، وصالح المهدي المُكنّى بـ"زرياب". وضمن فرقة الإذاعة، برزت مواهب كبيرة في الغناء والعزف.وفي مطلع الستينيات من القرن الماضي، ازداد الاهتمام بالثقافة والفنون، وتم بعث مهرجانات مسرحية وموسيقية وسينمائية مثل مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات، وألقى الزعيم بورقيبة خطابًا دعا فيه إلى الاهتمام بالمسرح لتهذيب الأذواق، ونشر الأفكار الحديثة في مجتمع مشدود إلى ماضٍ تتحكم فيه التقاليد البالية. وفي هذه المرحلة، برز المخرج المسرحي الكبير علي بن عياد الذي أخرج مسرحيات لويليام شكسبير والحبيب بولعراس. ولكي لا يقتصر المسرح على العاصمة وحدها، تم بعث فرق مسرحية في المدن الداخلية مثل الكاف وقفصة والقيروان والمهدية وغيرها... إلا أن بورقيبة غفل أو تغافل عن أمر أساسي، وهو أن الدولة الوطنية الحديثة التي تحمّس لبنائها تحتاج إلى الديمقراطية. وبسبب غيابها وانعدامها في ظل الحكم الفردي، وسيطرة الحزب الواحد على الحياة السياسية، بدأ المد الثقافي والفني الذي عرفته تونس خلال الستينيات يشهد انحسارًا وتراجعًا مع بداية السبعينيات تزامنًا مع اشتداد الحركات الاحتجاجية داخل الجامعة وخارجها. وعندما شرع النظام في محاكمة المعارضين والنقابيين، وجدت أجهزة الرقابة الفرصة سانحة لضرب كل كلمة أو صوت لا ينسجمان مع سياسته. مع ذلك لم ينقطع المثقفون والفنانون عن المقاومة بطرق مختلفة، متحدين أجهزة الرقابة. ومع مطلع الثمانينيات، عاشت تونس صحوة ثقافية وفنية جديدة أذابت بسرعة جليد السبعينيات. ولعل ذلك يعود إلى ما سمّاه البعض بـ"ربيع الديمقراطية" حيث جنح النظام بعد أحداث "الخميس الأسود" الدامية في جانفي/كانون الثاني 1978، والهجوم المسلح على مدينة قفصة في نفس الشهر المذكور من سنة 1980، إلى تعديل سياسته بهدف التخفيف من وطأة الاحتقان السياسي والاجتماعي. وفي هذا المناخ "الديمقراطي"، استعادت الحركة الثقافية والفنية حيويتها في مجال الأدب والمسرح والسينما والفنون الأخرى. وكانت مسرحية "غسالة النوادر" من أبرز الأحداث الثقافية في تلك الفترة. أما الحدث الثقافي الآخر فقد تمثل في العرض الافتتاحي لمهرجان قرطاج في صيف 1980. فمن خلال ذلك العرض البديع، اكتشف التونسيون، خصوصًا سكان المدن، ثراء الفن الشعبي، وجمال الموسيقى الفولكلورية في مختلف مناطق البلاد. لكن بعد انتفاضة الخبز مطلع 1984، عادت أجهزة الرقابة لتمارس من جديد سياسة القمع والترهيب والمنع تجاه المبدعين والفنانين في جميع المجالات. وبعد إزاحة الزعيم بورقيبة من كرسي الحكم المطلق في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1987، وفّر نظام بن علي للثقافة الرسمية المساندة لنظامه كل الوسائل الممكنة المادية منها والمعنوية، لمواجهة الثقافة المضادة بكل تعبيراتها. إلا أنه فشل في ذلك فشلاً ذريعًا إذ أن الثقافة المنتصرة للحرية ظلت تقاوم بجرأة وشجاعة مختلف الضغوطات والعراقيل. وهذا ما انعكس في العديد من الأعمال المسرحية والموسيقية والأدبية...لا عازف الكمنجة ولا الراوي الأعمى يثقلان المشاهدين بخطابات مطولة عن المراحل المفصلية في تاريخ تونس بعد حصولها على الاستقلال، بل يقتصران على الإشارة إليها بالهمز واللمز، أو باللمحات والإشارات الذكية، أو بكلمات مختصرة للغاية، فاسحيْن المجال واسعًا للموسيقى والغناء والرقص لتكون هذه التعابير هي الناطقة الفعلية والحقيقية بمضامين المسرحية الفنية منها والسياسية والاجتماعية، وهي العاكسة لها بأفضل صورة ممكنة. ولعل هذا الاختيار الذي يجنح إلى اختصار الخطاب، والتخفيف من ثقله، عائد أساسًا إلى استفادة فاضل الجزيري من تجربته السينمائية. ففي السينما تكون السيادة للصورة. أما الكلمة فحضورها ثانوي إن لم ينعدم في بعض اللقطات خصوصًا حين تركز الكاميرا على تعابير الوجه، أو العينين. وقد تمر دقائق من دون أن نسمع كلمة واحدة مثلما هي الحال في بداية فيلم "حدث ذات مرة في الغرب" للمخرج سارجيو ليوني. ونحن نستمع إلى عازف الكمنجة وإلى الراوي الأعمى، لا نشعر بأي تذمر أو شكوى من هذا أو ذاك، بل هما يرويان الأحداث كما لو أنها لا بد أن تقع لأن التاريخ لا يستشير أحدًا في تدفقه نحو ما هو مأساوي أو نحو ما هو مفرح ومُبهج. لذلك فإن عازف الكمنجة يواجه المصاعب التي اعترضت مسيرته الفنية بالسخرية المرة، وبالدعابة السوداء. فلا دموع ولا بكاء ولا أحزان مفتعلة ولا تخاذل بل كبرياء وشموخ واعتزاز بالنفس وجرأة فنان اختار الطريق الصعبة ويرفض أن يتركها حتى في أسوأ الأوضاع والحالات. وحتى عندما تستبد به مشاعر الإحباط واليأس، تأتي زوجته مسرعة لتعيد له التوازن النفسي المرغوب...عازف الكمنجة والراوي الأعمى هما صورة لجيل ما بعد الاستقلال الذي واكب بناء الدولة الوطنية الحديثة، وكانت له آمال وأحلام كثيرة، ورغبة جامحة في التحرر من كل القيود، إلا أنه اصطدم بنظام تسلطي، وبأجهزة رقابة عنيدة وشرسة، وبالعديد من العراقيل الأخرى. مع ذلك، لم يتخاذل، ولم ينكسر، ولم يخضع أبدًا لسياسة البطش والقوة، بل ظل يقاوم بإصرار وعناد ليحقق ولو البعض من أحلامه وأمانيه. وتنتهي المسرحية بسقوط نظام بن علي، وبانفصال عازف الكمنجة عن زوجته... وبالرغم من هذه النهاية الحزينة المفتوحة على المجهول، فإن فاضل الجزيري يمنح التونسيين إشراقة الأمل من خلال الرقصة البديعة التي أشرت إليها سابقًا...
|  جرانتي العزيزة..عن التاريخ الفني والسياسي في تونس
جرانتي العزيزة..عن التاريخ الفني والسياسي في تونس



 مسرح
مسرح أضيف بواسـطة addustor
أضيف بواسـطة addustor الكاتب
الكاتب  أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة
 الوقود الأحفوري لازال في المقدمة
الوقود الأحفوري لازال في المقدمة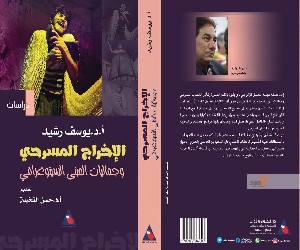
 قريبا .. الاخراج المسرحي وجماليات المبنى السينوغرافي بمقدمة من حسن النخيلة
قريبا .. الاخراج المسرحي وجماليات المبنى السينوغرافي بمقدمة من حسن النخيلة
 المسرحي العراقي حازم كمال الدين شخصية العام الثقافية في بلجيكا
المسرحي العراقي حازم كمال الدين شخصية العام الثقافية في بلجيكا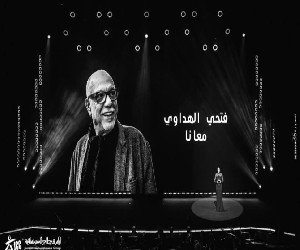
 العرض التونسي ((البخارة)) يفتتح الدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان
ستة عروض إماراتية تتنافس على جوائز أيام الشارقة المسرحية
العرض التونسي ((البخارة)) يفتتح الدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان
ستة عروض إماراتية تتنافس على جوائز أيام الشارقة المسرحية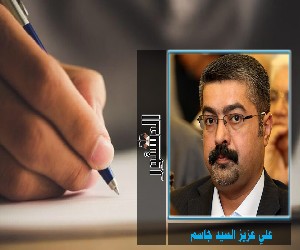
 في الهواء الطلق
معالجات معضلة المنصات الهابطة
في الهواء الطلق
معالجات معضلة المنصات الهابطة توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


