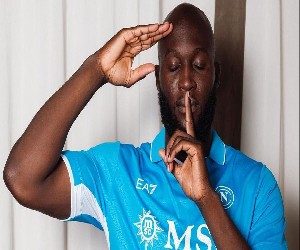زيرفان أوسي يوتوبيا بحجم الكف
زيرفان أوسي يوتوبيا بحجم الكف
 |
| زيرفان أوسي يوتوبيا بحجم الكف |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
ناصر أبوعون عندما توغل في نصوص الكردستانيّ زيرفان أوسي، سترى صورة شعرية بِكْر، تنطلق من بؤرة النصّ إلى الحواف في حركة مكوكية، وسرعان ما تنفلتُ من عقال القصيدة إلى مدار تخييليّ أوسع براحًا، صور يحاول الشاعر دؤوبًا من خلالها إعادة تشكيل العالم، وفك شفرات الغموض المُغرّض، وسعيًّا حثيثًا لا يكلّ وراء العلاقات المتخفية وركدًا وراء الظواهر الطبيعية والإنسانية لاكتشاف جوهرها، مسكونًا برغبة محمومة في الجمع بين العناصر المتضادة، وتقريب الرؤى المتنافرة، وبناء جسور تستدرج القاريء إلى دهاليز النصّ؛ لإشراكه في إعادة بناء عالم جديد، وصياغة رسالة أجدّ ذات خطاب عِرفانيّ ووجدانيّ واضح الدلالات. في هذه القراءة حاولنا البحث فيما وراء الصور الشعرية التي تشغل المساحة الأكبر من مدونة زيرفان أوسي؛ لنكتشف أنها صورة من (النمط التّخيليّ) بامتياز، وتتنوّع ما بين (المفردة، والقصيرة والطويلة)؛ فأمّا (الصورة المفردة) ترتكز على اقتناص الشاعر زيرفان أوسي كلمة واحدة/ مفردة يتيمة؛ ليجعل منها بؤرة مركزية للصورة الشعرية، وهي بمثابة منمنمة أو قطعة عضوية من جسد صورة متكاملة/ فسيفساء شعرية مشعّة، وأداته في صناعة هذه الصورة، (صفة) لموصوف خفيّ أو ظاهر، مرصوفة ومتتالية وما تحمله من شحنات نفسية متوهجة تعبر عن (إحساس بثبات الأشياء وسكونها)؛ إنها شَرَك أو متاهة لاستدراج القاريء مشدوهًا باللقطات المتتابعة ساعيًا وراء شهوة اكتشاف سياقاتها والوعي بمدى ارتباطها أو تنافرها؛ غير أنّ طبيعة هذا الضرب من التراكيب، تلجيء الشاعر إلى تحريك (المفردة اللغوية) عبر الصفة، وذلك كسرا للرتابة وتمهيداً لتطور الصورة الشعرية. وأمّا النوع الثاني من الصور الشعرية؛ فهو (الصورة القصيرة) التي ترتكز على الركنين الأساسيين للجملة العربية (مبتدأ وخبر) أو (فعل لازم وفاعل) أو تشبيه بليغ (مشبه ومشبّه به) أو استعارة مكنيّة وحالة الارتكاز على الاستعارة في بناء الصورة القصيرة سنجد الشاعر يعتمد على علاقات الشبه وسيلتها: الفعل أو وسيلتها الإضافة. إنها استعارات تعكس إحساسًا بالثبات ترتكزعلى الوصف وتنفر من الحركة التي تتمتع بها الاستعارة بالفعل، وكثيرًا ما ترتكز هذه الاستعارات على التجسيد لا التشخيص، وتستعير صفة الحياة، وتمنحها مجانًا للجمادات. أمَّا النوع الثالث من صور زيرفان أوسي؛ فهي (الصورة الشعرية الطويلة)؛ وهي تشمل النص من رأسه/العنوان إلى أخمص قدميه/القفل الأخير؛ وهي تشبه إلى حد ما شريط سينمائيّ تتابع مشاهده، وسطورها سيناريو يمثل حالة إنسانية واحدة أو مقطع عرضي مجتزأة من حياة تضجّ بالمتناقضات على هامش الحياة الكبرى التي يعيشها إنسان ما بعد الحداثة؛ الذي أغوته الندّاهةُ- أسطورة روح أنثوية آسرة الجمال تنادي الرجال بصوت عذب- فسار وراءها إلى المجهول، وابتلعته دوامة العولمة، وطحنت عِظام تراثه القديم ومحت هويته- ومن مزايا الصورة الشعرية الطويلة وأهمها على الإطلاق؛ تكمن في قدرتها على استيعاب التجربة الشعرية، التي كلمّا تمددت داخل طبوغرافيا النصَّ تزداد تعقيدًا، وتتوهج طاقتها، وتدفع الشاعر إلى القفز في أتون التجديد؛ ليحترق بنارها. ولا شك في أن اتجاه بعض الشعراء إلى كتابة المطولات الشعرية كان عاملاً حيويًا ساعد على بروز شاعريته واتساع مدى تأثيره في المشهد الثقافيّ- خاصة إن كان يصدر عن طبع متأصل- وسأتركك عزيزي القاريء دقائق معدودة مع بعض مختارات من ديوان الكردستاني زيرفان أوسي (يوتوبيا بحجم الكف) لعلك تكتشف الكثير مما غاب عني. (01) أخبرني أيّها الصدع في الكلمة أموتٌ هذا الرماديُّ في نعشِ الغروبِ؟ كيفما يجيءُ، يتأهّب كي يلمسَ وجهاً لم أعد أعرفه. (02) أيتها الرمالُ التي تمقتُ وطأةَ الأقدامِ أما زلتِ تنتشين بحركة البحر؟ (03) مجاز آخر يضاهي جنون العالمِ المائل رأسهُ نحو جدار التاريخ في صرخةٍ سريّةٍ أظنّها الكلمات لم يقلها سوى الرماد. (04) للجزرِ الممدودةِ على جسدك بقيّة ثورةٍ لم تكتمل إنْ كنتِ ماءً أو سراباً فهذا الكونُ يجري في شريانِ الحبِّ. (05) خريفٌ يُبطئُ حركتهُ سيفيق ورقاً لَمْ يُهيَّأ للسقوط. (06) أصغِ إليَّ يا نَفَساً ينضجُ أصغِ إليَّ أنت أوضح من هدنةٍ أدهش من ظمأٍ. (07) من يشعلُ قنديلاً أمام الشمسِ؟ من يرى الأعمى بعصا البصيرة؟ (08) أيّنا بوصلة لولادةٍ لاسم ينشأ في الحربِ؟ لخريطة جحيمٍ بين فراديس العباد؟ (09) في أرضٍ ميتةٍ يقتربُ المدى من لذتي. أيّنا رأسٌ لهذا القتلِ؟ من يمحو أفلاكهُ ليعبر في الظلام؟ من يبطئُ شعاع الوجود لا يدخلُ في النهار مرتين. (10) جئتُ متأخّراً، الشارعُ مجرّدُ حدسٍ الشارعٌ حدسٌ مختلفٌ خالٍ من البشريّ خالٍ من الأشياء الضيقة من الرؤوس الكبيرة من اليقين. (11) ذائبٌ، مُعتمٌ هذا الجسدُ يبقى هو الأنقى العتمة النقيّة. |
| المشـاهدات 105 تاريخ الإضافـة 29/06/2025 رقم المحتوى 64353 |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد