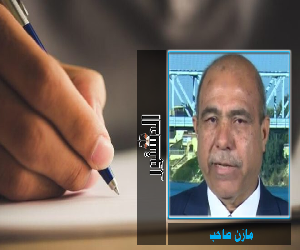مبدعون عراقيون في أستراليا
قراءة في المجموعة القصصية (ضوء أزرق من آخر النفق)
مبدعون عراقيون في أستراليا
قراءة في المجموعة القصصية (ضوء أزرق من آخر النفق) |
| مبدعون عراقيون في أستراليا قراءة في المجموعة القصصية (ضوء أزرق من آخر النفق) |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص : هيثم بهنام بردى
[ ضوء أزرق من آخر النفق ]، هي المجموعة القصصية الثانية للقاصة الشابة الواعدة مريم نزار الديراني غِبَّ مجموعتها الأولى الموسومة (بحار زرقاء وأعماق ملونة) الصادرة عن المركز الثقافي السرياني ببيروت عام 2019، والتي أصدرتها وهي لم تتجاوز سبعة عشر عاماً من العمر. والملفت للنظر أن ثمة تواشجاً بين عنواني المجموعتين لو أخذنا بالاعتبار الدراسات التي تتناول العنونة كعتبة للدخول إلى المتن، وادراج اللون الأزرق في عنونة المجموعتين ربما جاء عفواً أو قصداً فإن كان عفواً فحسناً فعلت القاصة الشابة باستثمار هذا اللون بمدلولاته التي تشير إلى أنها، وبحسب موقع [ تحليل الشخصية https://tahleelalshakhsiyah.com " ]: (اللون الأزرق هو لون السماء والبحر، وهو لون ينتشر جداً في الطبيعة، فهو لون السلام والراحة والهدوء، ويرمز إلى الكثير من المعاني الجميلة والراقية). وإن كان الأمر عن سابق تصميم فلربما الأمر يتعلق بشخصية المؤلف، ففي الموقع نفسه يورد صفات من يحب اللون الأزرق بأن: (ولا بد من أن محبي هذا اللون قد يتأثرون قليلاً في بعض من ميزات هذا اللون، فقد يرى أخصائيو علم النفس أن للألوان تأثيراً كبيراً على شخصية ونفسية وصفات الإنسان بشكل عام، والصفات التي يتمتع بها الأشخاص الذين يحبون اللون الأزرق كثيرة ومميزة بحسب العديد من الدراسات، وتختلف هذه الصفات فمنها الإيجابية ومنها السلبية، وفيما يلي سنذكر أهم هذه الصفات البارزة عند هؤلاء الأشخاص والتي قد تساعد في تحليل شخصياتهم. فالذي يحب هذا اللون: جدير بالثقة ومتواضع، منظّم، ودود واجتماعي، هادئ ويحب السلام، عاطفي ورومانسي، مثقف، صريح وصادق). فإن تطابقت صفات سمات اللون مع دلالات شخصية القاص فإن العنونة جاءت متوافقة من تينك السجايا، إن كانت مريم أوردت العنوانين عن دراية أم أن التلقائية هي التي استدعت الذائقة الابداعية للانضواء تحت فيء الأزرق فإن ما اجترحته يسجل لها كفعل ايجابي. ولكون العتبة كما يشير الدكتور محمد عبدالله القواسمه في بحثه الموسوم " الاهتمام النقدي بالعتبات النصية" المنشور في صحيفة الدستور الأردنية في 25/ 2/ 2021: (لا شك أن العتبات النصية من القضايا المهمة في النقد الأدبي المعاصر، بل هي حقل معرفي مستقل قائم بذاته، ولأهميتها في استكناه النصوص وبيان خفاياها حظيت باهتمام النقاد والباحثين، وبخاصة عتبة العنوان بوصفها عتبة أساسية تمنح النص هويته وكينونته، وهي المفتاح الذي يساعد المتلقي على فتح مغاليق النص، وسبر أسراره.). فلا بد والحالة القارة هذه –ضمن المفاهيم النقدية الراسخة- من التواشج المتين حد التماهي بين العنوان والمتن، وهذا ما سنحاول اكتشافه من خلال قراءة القصص. تتوزع قصص المجموعة على قسمين اختص الأول منها على قصصها القصار جداً فيما احتوى الثاني على قصصها القصيرة. وسأسجل انطباعاتي القرائية عن القصص الواردة في القسم الأول منها. فأقول في التوطئة: إن نأينا بالمقولة القديمة التي تحددها عدد كلمات القصة وكثرة الاجتهادات والتخمينات حول هذا الأمر، نرى أنه لم يتفق جلّ المنظرين والنقاد على العدد المحكم والمحدد الذي يمكن أن تنضوي تحت لواءه القصة القصيرة جداً، وبقي هذا التخمين بين كرّ وفرّ قائماً لحد الآن، غير منتبهين إلى التنظيرات الجديدة والمقنعة التي ظهرت بعد التجارب والتكهنات والتوكيدات على أن القوانين التي سورّت بنية القصة القصيرة جداً قد عبرها وعافها التطور الذي حصل بتصرم العقود الزمنية في السنن والأسانيد والكينونة والجنس، فترك النقاد المشكلة العويصة المختلَف عليها بعدد الكلمات وتمترست وانقادت في جلّها إلى عين المفاهيم التي ترتديها صنوها القصة القصيرة سوى من بعض الاختلافات، فلحقت بسابقتها القصة القصيرة من ناحية الحبكة والثيمة وزاوية التناول والبناء... وسواها، مع اختلاف بسيط يتعلق باللغة والسرد والمكان والزمان والقفلة. العنوان في القصة القصيرة جداً: العنوان عند الناقد والمنظّر الفرنسي جيرار جينيت Gérard Genette: (مجموعة من العلاقات اللسانية... التي يمكن ان توضع على رأس النص لتحدده وتدل على محتواه لإغراء الجمهور المقصود بقراءته. يحدد العنوان هوية النص ويشير إلى مضمونه كما يغري القراء بالاطلاع عليه(.. من هذا المفهوم ننطلق إلى الدخول في عالم العنونة لدى القاصة الشابة مريم نزار الديراني، ونحدد العلاقة الجدلية ما بين العنوان والنظرية أو المصطلح، وأن أول ما يطالعنا في عناوين القاصة ديراني هو عناوينها المركبة والتي تتألف من كلمتين أو ثلاث أو أربع مثلاً وسأورد قسماً منها كمثال وليس الحصر (حافة تولد إنساناً، تحية من أور نمو، نحو اللا معروف، حب مبني على النظر، ضوء القمر، برد أقوى من النور، ليلة أسميتها الهدوء، فصول لمشهد واحد، انتصار على حداثة مجتمعية، حلم على ضفاف دجلة، حوار دون حوار، الطريق إلى الجلجثة، خريف يطغي على شتاء.... وسواها)، فينبغي على هذه العناوين أن تكون مدخلاً للنص لفك مغاليقه، لا لافتة تختصر النص بطريقة تشوه معناه، وعند تعّمقنا بالقصص المنضوية تحت هذه العناوين وجدنا أعمها يتواشج المتن مع العنوان لإيصال المضمون إلى المتلقي بحيث لو شطب على العنوان وأتي بغيره لكان قريباً جداً منه إن لم يكن نسخة مطابقة منه، وهذه حالة ايجابية حازتها النصوص لتحقيق المبتغى، وإن العناوين المثبتة على هامة القصص لم تكن مجرد واجهات براقة للتجميل بل دلالات وإشارات لتثوير النص بعنوانه الموحي وخاتمته الواخزة لإثراء ذائقة المتلقي. ماهية الجنس السردي: تشير الدراسات الحديثة إلى انحسار شرط عدد الكلمات في القصة القصيرة جداً لكونها تبتعد عن الاشتراطات الأخرى لهذا الجنس الجديد "الأخ الأصغر للقصة القصيرة"، المتمثلة بالبنى الارتكازية لها "الوحدات- البناء- زاوية السرد- الوصف"، متجاوزة القفلة الختامية الصادمة التي تفضي الكثير منها -نظراً لقصور الفهم أو محدودية الموهبة أو ضبابية الرؤية- إلى الطرفة أكثر مما تعزز الكينونة كجنس سردي، ونحتنا في بني قصص مريم الديراني القصيرة جداً، لوجدناها متوفرة في جل القصص والتي لن أشير إليها بالاسم، فهي تتوافر على الوحدات البنائية "الزمان، المكان، الحدث"، وأضيف إليها تواجد الشخصية بملامح محددة تارة وشبه منظورة تارة أخرى، مع انصهار الذات المفردة في دورق الذوات المتعددة، لتسحب الحدث في مكان محدد أو فضاء مطلق إلى ذوات جمعية "نحن" لا تتعاطف من الأنا آنياً بل تتماهى معها في ذات "فردية-جمعية"، وهذا ما تجلى في قصص (شمعة، ضوء القمر، مشاعر رمادية، أقوى من الموت، مهرج، ألوان الفرح). والبناء الذي جوهره وجماره "البداية- الذروة- النهاية" والتي تمخضت عن تجربة تربو على القرن ويزيد تمحورت في هذا الجنس الجديد بأن لا تتجاوز مقدمتها عن سطرين أو ثلاثة، وذروتها لا تحتمل أكثر ثلاث أو أربع حوادث في مشهد واحد، وأن تكون النهاية برقية متمركزة في بؤرة بارقة وواخزة.... وهذه السمات تجلّت أيضاً في العديد من النصوص باستثناء الأخيرة التي كانت شبه غائبة وهذا بتقديري الخاص وضمن تجربتي الطويلة نسبياً في كتابة هذا الجنس لم أعد أراها ذات جدوى وأن تشترط نجاح كتابة الجنس من فشله مرتبطاً بهذا الشرط. وما سبق وأن قلته بالنسبة للطول فهو غير مقرون بعدد الكلمات التي أطرّها المنظرون الأوائل والذي تفاوتت بحسب ترنتويل ميسون رايت ما بين (500- 1500) كلمة، وآخرون أقل وأكثر، ولكن مع تقادم السنين تبين وبجلاء أن عدد الكلمات –وإن كان أقل بكثير من الشقيقة البكر القصة القصيرة- ليست العلامة الفارقة لكتابة نص مكتمل بل أن تطبيق الأسانيد الأخرى هي التي تحدد كتابة نص متقدم وناضج، وهذا ما تحقق على يد القاصة في البعض عير اليسير من قصصها. تآصر السرد والأسطورة والموروث الإيماني والفلسفة ونقد الظواهر في قصص ديراني: أولاً: الأسطورة. لو تأملنا قصص (تحية من أورنمو، حلم على ضفاف دجلة، أساطير من الواقع، الصدع ) نجدها تستعير شخصيات من عمق التاريخ الرافديني "كلكامش، نبوخذنصر، ألف ليلة وليلة، بانيبال، أماجي أوركاجينا، عشتار، ديموزي، أنكيدو.... إلخ) والسؤال هنا يجب أن يتواجد في ذاكرة وذائقة القاص قبل القاريْ يتمحور حول تمكنه من استعارة هكذا شخصيات لها مدلولها الباهر في عمق التاريخ وذكرها في بطون الكتب والذاكرات في عصرنا الحاضر والقابل، وتوظيفها بكافة منابعها ومشاربها في نص قصير جداً ووامض ليقوم بتفعيل الحدث ويعطيه قوة وتجذراً في ذائقة المتلقي من خلال اتكاء فعل حياتي معاصر على روح الأسطورة ليجد لها مكاناً في الذاكرة كنص متقدم يماهي الحاضر بالماضي الزاهر ويستعير الشخصية الاسطورية ليجبب بها شخصية معاصرة. بسرد يلج مسالك ضيقة ووعرة وعلى القاص أن يوظف السرد القصصي القصير جداً في جنس شديد الخصوصية، شديد القصر، وعصي البنيان صعب بلوغ شعفه إلاّ لمن يتسلح بالمهارة في السرد والبناء السليمين. ثانياً: الموروث الإيماني. مثلما أسلفنا فيما قلناه عن القصص التي تستعير الشخصيات الاسطورية الرافدينية ومعالجتها وتوظيفها في النص القصصي القصير جداً، وجعلها الطوطم الذي تدور في فلكه أحداث القصة كقصص (دولاب الزمن، الطبيعة، الطريق إلى الجلجثة)، نرى القاصة تستعير وبشكل منطقي يخدم النص ودلالاته لتشيده بشكل مقنع. ثالثاً: الفلسفة. منذ أن عرف الحرف واكتشفت المفاهيم الانسانية انبثقت الفلسفة التي (تعني حرفيًا «حب الحكمة» هي دراسة الأسئلة العامة والأساسية عن الوجود والمعرفة والقيم والعقل والاستدلال واللغة.) بحسب ويكيبيديا.، وتأسيساً على هذا نجد مريم تنحت نصوصها وتسحب السرد نحو عوالمها المليئة بالتساؤل والجدل والاستنباط والاستنتاج ويظهر ذلك في العديد من قصصها التي تستدعي منابع الفلسفة ببعض تشفيراتها وتجلياتها وصورها التي تتجلى هنا وهناك لينحو النص باتجاه حِكَم تتحدث عن الوجود والعدم، وتكرّس بعض القيم السامية، ولعل ولعها بترسيخ هذه الدلالات يكون على حساب البني الارتكازية للجنس، فتتسرب القصة من بين أنامل ذاكرتها على شكل مَثَل أو مفهوم أو دلالة ايجابية تنأى بعيداً عن السلبية، وهذا ما تجلى في قصصها (حافة تولد إنساناً، الثقب، نحو اللا معروف، خلف الجدار، برد أقوى من الموت، كتاب الطفولة، تفاؤل، ليلة أسميتها الهدوء، فصول لمشهد واحد، الصدع، ألوان الفرح، تبعية). رابعاً: نقد الظواهر. حاولت في قصص (الارستقراطي، حب مبني على النظر، دولاب الزمن، ضوء القمر، مشاعر رمادية، البقاء، مهرج، سعي بحب، معتقدات عصرية، مساواة.... وسواها) أن تطرح بعض الظواهر والممارسات الحياتية التي خرجت من المفاهيم الحياتية المتوارثة القارة وتشكلاتها مع معطيات العصر الحديث بكل ارهاصاته ومسبباته ونتائجه، أفلحت في بعضها بتقديم البديل الايجابي بطريقة سردية مقنعة فيما اعتور أخريات السبك التقريري المباشر. خامساً: البعد النفسي. في نصوصها (شمعة، نحو اللا معروف، خلف الجدار، ليلة أسميتها الهدوء، فصول لمشهد واحد، الصدع، ألوان الفرح، خريف يطغي على شتاء) تحاول مريم الغور إلى الأعماق السحيقة المسكوت عنها في دخيلة الشخصيات وقد استخدمت المرآة في جلّها لاستكناه دواخلها الخبيئة وأفلحت في مقصدها وأسجل لها اعجابي باستخدامها المرآة لما لها من مدلولات في العلاج النفسي واكتشافاته وتجلياته ونتائجه. وقبل الختام: أرى أن مريم حاولت أن تتوغل في الأبعاد النفسية والحياتية بدلالاته النيّرة لمديات اللون الأزرق واستطاعت أن تفتح كوّة تسللت منها شعاعاتها إلى أغوار ذائقة المتلقي وأشاعت في أهراء الروح السكينة والنقاء والبساطة والتأمل واستنباط كل ما يستدعي التفاؤل والأمل حتى من أكثر النصوص إيغالاً في العتمة. ختاماً: أنا موقن بأن مريم -وهي لما تزل في مقتبل عمرها الابداعي- قادرة في المستقبل القريب على كتابة قصص قصيرة جداً تتجاوز بعض الهنات والمثالب التي رافقتها في مجموعتها القصصية هذه، وتكتب قصصاً تشيّد من خلالها ذاتها الخاصة. |
| المشـاهدات 1345 تاريخ الإضافـة 16/07/2025 رقم المحتوى 64822 |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد