| النـص : منذ عام 2003، وجد شيعة السلطة في العراق أنفسهم أمام معادلة معقدة: كيف ينتقلون من فضاء التاريخ، الذي برعوا فيه تأويلًا واستحضاراً، إلى حقل الدولة، الذي يتطلب إدارة واقعية حديثة؟ لقد أثبتت التجربة أن الشيعة في العراق يجيدون السرديات، لكنهم يتعثرون أمام معادلات الحكم وبناء المؤسسات. وبينما يظل التاريخ ساحةً مفتوحةً للرموز والتفسيرات، فإن الدولة لا تقبل سوى منطق المؤسسات والعلمية والتخطيط، وهو ما لم يترسخ في وعي الطبقة السياسية الشيعية، التي وجدت في التغيير بعد 2003 فرصة للسلطة، لا للدولة. لطالما كان سؤال الدولة مؤجلًا في الوعي الشيعي السياسي، إذ لم يكن حاضراً في الأدبيات الفكرية التي صاغت رؤيتهم للسلطة. وحين ساهموا في تأسيس الدولة العراقية الحديثة، كان جلّ اهتمامهم ينصب على الرمزية السياسية، كما تمثل في دعمهم للملك الهاشمي، لا على بناء الهياكل التأسيسية للدولة. ومع سقوط نظام البعث، لم يمتلكوا تصوراً واضحاً لمفهوم الدولة الحديثة، فاستعاضوا عنه بـالشعارات، مرتكزين على خطابين متلازمين: العدو الخارجي، والقلق الداخلي . وفي ظل غياب المشروع، لم يسعَ شيعة السلطة إلى بناء المؤسسات أو تعزيز دور النخب، بل عملوا على احتكار التمثيل الداخلي، دون إدراك أن السلطة لا تعني الدولة، وأن الحكم لا يترسخ بالشعارات وحدها. وهكذا، أصبح السؤال الجوهري غائباً: كيف تبنى الدولة؟ وبدلًا من الإجابة، كانت هناك محاولات لتأجيل السؤال، عبر تكريس أزمات سياسية لا تنتهي، مما جعل البلاد تغرق في دوامة الفوضى والانقسامات . هنا تتجلى المفارقة بين الشرعية والمشروعية. فالشرعية تستند إلى القانون والدستور، أما المشروعية فتعتمد على القبول الجماهيري. ومنذ 2003، ظلّت الشرعية شكلية، بينما المشروعية غائبة، إذ إن أكثر من ثلثي العراقيين قاطعوا الانتخابات، فاقدين الثقة في العملية السياسية. غير أن السلطة وجدت في هذا العزوف فرصةً للاستمرار دون مساءلة، مستفيدةً من شكل ديمقراطي ، بينما الواقع أقرب إلى ثيوقراطية مقنعة، حيث يُنظر إلى الحكم كتكليف إلهي، لا كمسؤولية أمام الشعب . لكن حتى داخل الطيف السياسي الشيعي، هناك انقسامات فكرية حادة. إذ تتجاذبه نظريتان : اولا . الحسينية : رؤية تقوم على استحضار الماضي والثأر الرمزي، وتكريس الوعي بالمظلومية . ثانيا. المهدوية : رؤية تركز على المستقبل، وترى أن التغيير الحقيقي مرهون بانتظار الخلاص . ورغم اختلاف المنظورين، فإن الأغلبية السياسية تتبنى المقاربة الحسينية، باستثناء المدرسة الصدرية، التي تقدم قراءة مختلفة تعتمد على دور شعبي أكثر حركية. وفي ظل هذا التباين، نشأ كيان سياسي غير واضح المعالم، لا يمكن تعريفه بدقة: هل هو دولة؟ سلطة؟ انتخابات؟ ديمقراطية؟ أوليغارشية ؟ . إن بناء الدولة يتطلب احتكار التمثيل الداخلي، والتغيير من الداخل، لا مجرد استثمار في الأزمات. لكن التجربة العراقية أثبتت أن التحولات السياسية الكبرى جاءت بتدخلات خارجية، مما أفقدها القدرة على تأسيس مشروع . لذا، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف نستثمر اللحظة الراهنة لصياغة مستقبل مختلف؟ إن تجاوز أزمة الحكم يتطلب إعادة تعريف الشيعية السياسية خارج ثنائية التيار والإطار، واستعادة مفهوم الدولة بوصفها مشروعاً قائماً على المؤسسات، التخطيط، والتحديث، لا ساحةً لصراعات الهويات والانقسامات التاريخية . إن التحول من سلطة الطوائف إلى دولة المؤسسات ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة تاريخية. فهل يستطيع شيعة السلطة كسر عقدة الماضي وأوهام الهيمنة، وطرح سؤال الدولة بعيداً عن مخاوفهم المزمنة؟ هذا هو التحدي الذي سيحدد مستقبل العراق .
|  سؤال الدولة: بين مخاوف الماضي وأوهام الهيمنة
سؤال الدولة: بين مخاوف الماضي وأوهام الهيمنة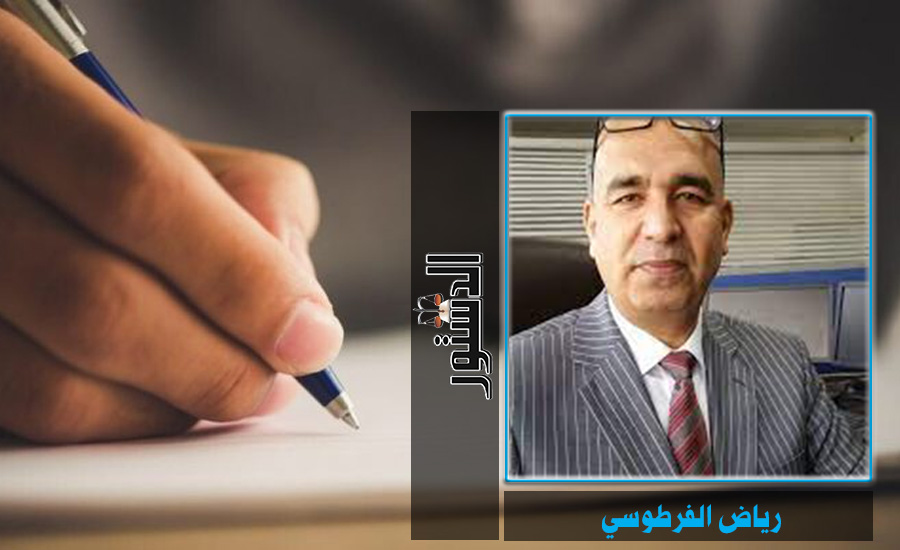



 كتاب الدستور
كتاب الدستور أضيف بواسـطة addustor
أضيف بواسـطة addustor الكاتب رياض الفرطوسي
الكاتب رياض الفرطوسي أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة
 بين التمن والريزو... إلى أين تمضي أطباقنا التراثية؟
بين التمن والريزو... إلى أين تمضي أطباقنا التراثية؟
 وسائل التواصل الاجتماعي ... بين الاتصال والانعزال
وسائل التواصل الاجتماعي ... بين الاتصال والانعزال

 القبض على 4 مطلوبين لهيئة النزاهة في بغداد
إعفاء إدارة تقاعد الديوانية وإحالة موظفين إلى التحقيق
القبض على 4 مطلوبين لهيئة النزاهة في بغداد
إعفاء إدارة تقاعد الديوانية وإحالة موظفين إلى التحقيق

 الاستخبارات تطيح بعدد من المطلوبين بالارهاب وتجارة المخدرات بعدد من المحافظات
بغداد وكركوك.. صاحب عجلة يدهس منتسبا والقبض على متهم بالإرهاب و"متحرش"
الاستخبارات تطيح بعدد من المطلوبين بالارهاب وتجارة المخدرات بعدد من المحافظات
بغداد وكركوك.. صاحب عجلة يدهس منتسبا والقبض على متهم بالإرهاب و"متحرش"
 الاستثمار: لجنة تحديد أسعار الوحدات السكنية ستراعي قدرة المواطنين الشرائية
الإعمار تحدد سببين لارتفاع اسعار العقارات
الاستثمار: لجنة تحديد أسعار الوحدات السكنية ستراعي قدرة المواطنين الشرائية
الإعمار تحدد سببين لارتفاع اسعار العقارات توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


