 كاظم اللايذ صورة ونظام إشاري
كاظم اللايذ صورة ونظام إشاري |
| كاظم اللايذ صورة ونظام إشاري |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
ناصر أبو عون
لن تستطيع أن تحضن تجربة الشاعر العراقي (كاظم اللايذ) الشعرية من قراءة شذرات متناثرة في الفضاء الأزرق، أو قصاصات ورقية نشرتها الصحافة الثقافية على استحياء؛ فلا مناص من تعكف على أحد عشر لوحًا شعريا منذ الخطوة الأولى (في الطريق إلى غرناطة 2006)، ثم (النزول الى حضرة الماء 2009)؛ لتتوضأ بماء الشعر، قبل أن تقرأ (أطراس حارس الزمن 2012)، وتنظر بعين فلسفة الجمال في (دفتر على سرير الرجل المريض1913)، وتدق بيد التاريخ على (بوابات بصرياثا الخمس 2015)، وتستبصر رؤاه الجوانيّة في (على تخوم البرية أجمع لها الكمأ 2017)، وتتأمل صوره الشعرية وهي تغرُب في عين حمئة (مثل طائر الفلامنكو يحجل على ساق واحدة 2019)، وتستبطن ذاتك معه وهو يرتشف عصير القصائد (بيدها تسقيني أكواب البابونغ 2021)، وتتبع خطاه حين (شُوهد مغادراً باب الهوا 2022)، وتتجول في ذاكرة البصرة المختصرة في (أم البروم.. رقعة بسعة العالم 2024)، وتنتظره حتى مطلع الطبع في(مقهى المعتزلة). في تجربة كاظم اللايذ الإبداعية تسيطر الصور الشعرية القصيرة على المساحة الأكبر من طبوغرافيا النصوص؛ وقوام هذا النوع من الصور عمودها الفقري إما تشبيه وإمّا استعارة؛ وكلاهما يعتمدان على الجانب الوصفي ويعكسان إحساسًا بالثبات. وإذا كان الشاعر يرتكز على التشبيه لمحاولة التقريب بين واقعين مختلفين ينتميان إلى العالم الخارجي، إلا أنّه يوظف الاستعارة باقتدار سعيًا منه لتجاوز الحدود المنطقية بين الأشياء أو ابتداع صورة كلية واحدة من فسيفساء مختلفة ومتنافرة من الصورة المتناهية في الصغر؛ وذلك من خلال مزجه بين الصور، عبر معادلة شعرية معقدة يتفاعل فيها التشبيه والاستعارة ويتبادلان التأثير والتأثر والوظيفة. على نحو ما نقرأ في قصيدته (الذي يمشي على اثنتين) التي يقول فيها:[من السهولةِ أن تعرف/ لماذا تدفعُ النخلةُ جذورَها عميقاً في الأرض/ وتُرسلُ عروقَها مثلَ شبكةِ العنكبوتِ في أغوارِ التراب؟ من السهولة أن تعرف/ لماذا يتأرجحُ طائرُ الوروار على أسلاك الكهرباء/ لاوياً منقارَه/ متهيّـئاً في أيةِ لحظة للانقضاض؟..الكائنَ الذي يمشي على اثنتين/ ويسمونَه الإنسان/ فليس لأحدٍ مهما خاض في أعماقهِ/ وتوغل في مخابئ أسرارهِ/ أنْ يعرفَ ما يريد؟ وما يبتغي/ وما يُضمره لمعايشيهِ من الدسائس/ وما ُيحوكهُ لسكنة الأرض من المؤامرات!] وملاحظة أخرى جديرة بالاهتمام وهي من سمات الصورة الشعرية بوجه عام وعند كاظم اللايذ بوجه خاص حيث تتبدّى الصورة الكلية وامتداداتها داخل النصّ مُؤسِّسةً على علاقة تجاورية / كنائية – وفق تعبير يا كوبسن – غير أنّ محاولة التفريق بين الخيطين (الاستعاري/الأبيض) و(الكنائي/الأسود) من البِنيتين تكاد تكون شبه ممتنعة، فالا ستعاري والكنائي يشكلان علاقة، يمكنهما من خلالها التداخل والاشتراك في تحقيق النظام اللغوي, وإنْ كان اشتراكهما معًا يفضي إلى تقويض الخصوصية الشكلية للحقل الإبداعي وذوبانها, وقد يؤدي إلى توجيه القراءة توجيها غير مناسب، ولكن هذا الذوبان ليس عيبا في ذاته، بل هو في أحيان كثيرة طابع أصيل في أي نظام إشاري، وأصالته هذه لا تلغي هيمنة أحد شكلي العلاقة على الشكل الآخر بما يفضي إلى تصنيف الحقل بحسب الشكل المهيمن, وهو ما لاحظه ياكوبسن، وإن لم يشر إلى فكرة الهيمنة وبدا الأمر عنده وكأن الفصل متأصل في البنية وإنها أحادية الشكل أصالة، غير أن التفاعل(النفس معنوي) نجح في بناء دلالي ومعماري يستقطب القاريء إلى عمق القصيدة اعتمادا على آلية التأثير النفسي. على نحو ما نقرأه في قصيدة (أرسمك):[أّرسُمكِ/ امرأةً من غيرِ قلب/أُنثى/من غير ثديينِ ولا شفتينِ ولا قُرطينِ ولا خواتم./أرسُمُكِ/فتاةً صلعاءَ/ دون ضفائرَ/ ولا قِذالٍ يتدلّى مثلَ المنجل على الجبين ../أرسُمكِ بقوامٍ ممصوع/مثلَ نخلةٍ عيطاء/أكلَتْ السّوسةُ جمّارَتَها/ وعاثَ بجريدها الدودُ الأسودُ/وكره وجودَها حارسُ البستان../أرسُمُكِ شاعراً دونما أَحزان/وفنّاناً دونما جُنون/ومهرّجاً من غير قضية /وفلَكياً من غير نجومٍ ولا سماءٍ ولا اسطرلاب../أسماكِ القاضي: طليقتي/ وجعلَ بيننا حائطاً مثل سور الصين العظم/ و مدَّ بحراً مثل بحر الظلمات/ وأشعلَ بيننا حرباً ضروساً/ مثلَ حرب البسوس/ لكنني/ سأظلّ أرسُمكِ/ وارسُمُكِ/وارسُمكِ] وتطبيقًا لنظرية (التفاعلية، التوترية) في (تحليل الخطاب الشعري) والتي ترتكز على مبدأ أن (الصورة الاستعارية) تتكون من شبكة من الكلمات أو الجمل الميّتة، ينفخ فيها السياق من روحه ويمنحها معاني حقيقية ومحدّد، وأن الاستعارة لا تحصل في الاستبدال وإنما تحصل من التفاعل بين بؤرة المجاز والإطار المحيط بها، وأن المشابهة ليست العلاقة الوحيدة في الاستعارة – وفق تعبير محمد مفتاح -، فقد يكون هناك علاقات أخرى. ونعثر على هذا النوع من الاستعارة في نص (العمة زكية: تحرسُ الزمن) [عمتي زكية.. تترجمُ لنا ما نسمعه/من أصوات الفواخت والقبّرات/والطيور المهاجرة التي تنعب في أعالي قبة السماء/وتستمع الى جذور الأشجار/وهي تتمددُ عميقاً باحثةً عن أَثداء لأرض./وذات يوم رأيتها, وكأنها تُصغي إلى شيء..سألتُها فقالتْ: أسمعُ الأرضَ تبكي]. إذن يتحرك كاظم اللايذ عبر قماشة واسعة من الخيال الخصب، ساعدته على بناء صورة تحمل طوي قلبه، وأفكار عقله كوسيط حيوي إلى المتلقي ولقد استطاع عبر توظيف الطابع القصصي إلى حد ما أن يمنح الصورة بعدًا زمنيًا ومكانيًا، مما أعطى مساحة لتصوير مناخ الحدث الذي كان مرتكزا لابتداع الصورة وتناميها وتتابعها وتوالدها. وفي الغالب يتداخل في هذا الحدث محوران: (صورة واقعية مُنتقاة) بعناية فائقة و(صورة مُتخيلة). ومنها قول الشاعر: [يوم أن ماتتْ.. كانتْ مسجّاةً على سرير من الجريد/ ورأسُها غاطسٌ بوسادةٍ من اللّيف/ ساكنةً مثلَ مومياء الملكة (حتشبسوت) في المتحف المصري/ مغمضةَ العينين/ لا يتحركُ منها إلاّ شفتاها/ تخاطبنا بصوتٍ خفيض/ وبأنفاسٍ متحشرجةٍ مودّعةٍ متلاشية:(خذوا بالكم من النخل)]. |
| المشـاهدات 27 تاريخ الإضافـة 05/04/2025 رقم المحتوى 61209 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة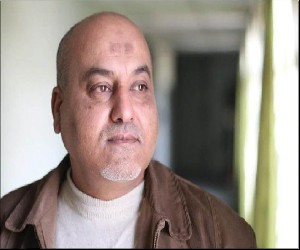 |
 المخرج عزام صالح : القنوات المؤدلجة تحاول تشويه صورة الدراما العراقية المخرج عزام صالح : القنوات المؤدلجة تحاول تشويه صورة الدراما العراقية
|
 |
 ناجلسمان..تغيير الصورة وإعادة الماكينات للهدير ناجلسمان..تغيير الصورة وإعادة الماكينات للهدير
|
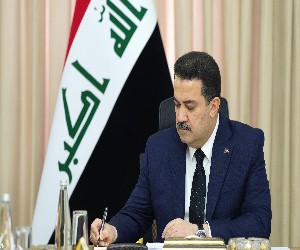 |
 رئيس الوزراء يعزي برحيل الفريق كاظم بوهان العكيلي
السوداني يؤكد دعم الحكومة للمراكز القرآنية ومسابقات الحفظ والتلاوة رئيس الوزراء يعزي برحيل الفريق كاظم بوهان العكيلي
السوداني يؤكد دعم الحكومة للمراكز القرآنية ومسابقات الحفظ والتلاوة |
 |
 كاظم : الخيارات الهجومية متاحة امام كاساس كاظم : الخيارات الهجومية متاحة امام كاساس
|
 |
 بمشاركة جنات.. كاظم الساهر يُهدي الأمهات أغنية خاصة بمشاركة جنات.. كاظم الساهر يُهدي الأمهات أغنية خاصة |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


