| النـص : الكاتب ياسين مجيد يدوّن شهادته كفاعل داخل المشهد لا كمراقب خارجي، كاشفاً خفايا القرارات الأميركية وحساباتها العميقة. ويربط بين الوقائع وانهيار المنظومة الأمنية وإحتلال الموصل بيد داعش، مقدماً سردية سياسية أقرب للاعترافات الداخلية، تكشف أبعاد المشروع الأميركي وتداعياته على العراق.لم يكن احتلال الموصل في حزيران/يونيو 2014 حادثة مفاجئة، بل نتيجة مسار طويل بدأ مع نهاية الحرب العراقية – الإيرانية عام 1988. فمنذ ذلك الحين تعرض العراق لحروب وضغوط أنهكت مؤسساته، بدءاً من حرب الخليج الثانية عام 1991 وما تبعها من حصار خانق، وصولاً إلى الغزو الأميركي 2003 الذي أسقط النظام السياسي وفتح الباب أمام الفوضى. الاحتلال الأميركي لم يكتفِ بتغيير الحكم، بل أسس لنظام هش قائم على المحاصصة والانقسام، ما أوجد بيئة ملائمة لصعود داعش واستخدامه كذراع لمشروع تفكيك الدولة الوطنية وتحويلها إلى “دولة مكونات”.إذا كان إحتلال بغداد عام 2003 لحظة انهيار المركز، فإن إحتلال الموصل عام 2014 جسّد انهيار الأطراف، في سياق استهداف منهجي لمقدرات العراق وهويته الوطنية.ياسين مجيد، بصفته شاهداً مشاركاً في صناعة الأحداث، يربط بين الأسباب والنتائج ليؤكد أن الموصل كانت مختبراً للفوضى منذ 2003: فراغ أمني، انقسامات طائفية، وتدخلات خارجية. القوى الدولية والإقليمية، ولا سيما واشنطن وأنقرة والرياض، لعبت دوراً محورياً في إعادة تشكيل التحالفات الداخلية بما عمّق هشاشة التوازنات.يتوقف الكاتب عند صراع آل النجيفي مع الكرد ودور واشنطن في “هندسة” تحالفات جديدة مع اقتراب الانسحاب الأميركي 2011، ومنها التقارب الكردي – التركي المدعوم سعودياً. انتخاب أسامة النجيفي رئيساً للبرلمان كان تتويجاً لهذا الترتيب لكنه ظل هشاً، وأسهم في إضعاف الموصل أمام داعش.مرحلة أثيل النجيفي تمثل بداية مشروع “شبه دولة مستقلة” في نينوى بدعم تركي، استند إلى ثلاثة أعمدة: محاكاة تجربة كردستان، واستدعاء ضباط البعث، وتمويل الجماعات المسلحة عبر “جزية” فرضت على المجتمع. بهذه الآليات تحولت نينوى إلى كيان موازٍ، حيث تغلغلت التنظيمات في المؤسسات وتحول الفساد إلى نظام حكم. لجنة مكافحة “الجزية” التي شكلها رئيس الوزراء المالكي لمواجهة هذه الظواهر، شلّها الصراع بين النجيفي وقائد العمليات مهدي الغراوي، فيما تحول القضاء إلى أداة سياسية أفرجت عن آلاف المعتقلين. حتى تظاهرات 2012، لم تكن احتجاجاً اجتماعياً بل غطاءً لإعادة تموضع البعثيين والجهاديين.هكذا تبلورت استراتيجية النجيفي: رفض التظاهرات الرسمية، الاصطفاف مع المسلحين، وخلق قطيعة مع بغداد، وتوظيف الإعلام لشيطنة الجيش ووصف المسلحين بالثوار. وبذلك أصبحت الموصل أكثر هشاشة من الأنبار، وتحولت إلى ساحة رفض مطلق للحلول.يربط الكاتب بين أحداث سوريا والعراق؛ فالتجربة السورية في الرقة 2013 ألهمت عسكرة التظاهرات بالموصل. صعود داعش لم يكن عسكرياً فقط، بل إعلامياً أيضاً. دمج البغدادي بين “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة” أكد أن العراق بات امتداداً للحرب السورية. ومن هنا استُخدم الإرهاب كأداة دولية لإعادة تشكيل المنطقة.لجأ أثيل النجيفي إلى صناعة روايات كاذبة، مثل اتهام ضابط شيعي باغتصاب فتاة، بهدف إشعال الفتنة الطائفية وتشويه صورة الجيش. المفارقة أن أي علاقة مع إيران اعتُبرت خيانة، بينما تحرك القنصل التركي في الموصل كحاكم فعلي دون اعتراض، بل حتى حادثة خطف موظفي القنصلية 2014 انتهت بسلامة جميع الضباط الأتراك، ما يوحي بوجود تنسيق خفي.كما يوضح الكاتب أن واشنطن منذ 2011 رسمت خطوط “عراق ما بعد الانسحاب” على ثلاثة أسس: إبقاء خلاف بغداد – أربيل ورقة ضغط دائمة، وتوظيف الطاقة لترجيح كفة تركيا وكردستان، والنأي العلني عن التظاهرات مع حضور غير مباشر عبر الإعلام والسياسة. لقاءات مع مسؤولين أميركيين مثل وليم بيرنز وكارلوس باسكال تكشف ازدواجية الخطاب: شراكة رسمية مع بغداد يقابلها دعم عملي لأربيل. حتى بايدن، لم يُخفِ تشجيع عقود النفط الكردية رغم تعارضها مع المركز.أما التظاهرات في الأنبار والموصل وسامراء عوملت أميركياً كأداة لإعادة التوازن، رغم ظهور عناصر القاعدة في ساحاتها. وهنا تكمن خطورة التحليل: واشنطن تركت الباب مفتوحاً أمام تمدد داعش في إطار موجة “الربيع العربي” التي انقلبت إلى صراع طائفي.من أبرز النقاط ما يسميه الكاتب “المصالحة الأميركية” بين آل النجيفي وبارزاني. فمجلس محافظة نينوى عام 2013 قرر إخراج الجيش والشرطة الاتحادية، خطوة اعتبرها الكاتب بروفة مبكرة لاحتلال الموصل، حيث عُدّ الجيش غريباً فيما رحّبت القوى نفسها بالبيشمركة.الهروب الكبير من سجن أبو غريب صيف 2013 لم يكن معزولاً بل متزامناً مع هروب جماعي في ليبيا وأفغانستان، في ما يشبه تنسيقاً لإعادة تجميع الجهاديين. أما ردّ فعل الطبقة السياسية العراقية، عكس انشغالها بالمكاسب بدل تهديد الدولة، فيما استثمرت قوى المعارضة الحادثة لتسجيل نقاط ضد المالكي بدلاً من مواجهة الخطر الداهم.بهذه القراءة يبين الكاتب أن احتلال الموصل لم يكن بداية الانهيار، بل ذروة مسار طويل من التفكك السياسي والاجتماعي، حيث التقت هشاشة الداخل مع هندسة الخارج، فانفتح الطريق أمام مشروع داعش لتفكيك الدولة العراقية.في خريف 2013، زار السيد نوري المالكي واشنطن طالباً السلاح لمواجهة خطر داعش، لكن ما واجهه كان رفضاً أميركياً صريحاً وتوظيفاً سياسياً للملفات العراقية. أوباما ركز على الخلافات مع الكرد والسنّة، واتهم بغداد بالتساهل مع الطائرات الإيرانية العابرة إلى سوريا، فيما رفض الكونغرس تزويد العراق بطائرات الأباتشي والـF-16. . المالكي ردّ بأن خصومه يزايدون عليه سياسياً، لكنه عاد بخفي حنين، في ظل حملة داخلية قادها بارزاني والنجيفي والصدر لتقويض سلطته.يرى ياسين أن المالكي واجه تحالفاً داخلياً شيعياً – سنياً - كردياً بغطاء خارجي، هدفه إضعاف الدولة المركزية. استخدمت القوى السياسية أدوات ديمقراطية كالمطالبة بسحب الثقة عام 2012 والمناورات الانتخابية، فيما استُغلت ساحات الاعتصام لتبرير صعود القاعدة وداعش. وبذلك لم يكن احتلال الموصل 2014 نتيجة فشل عفوي، بل جزءاً من مشروع ممنهج لإقصاء المالكي وإعادة رسم التوازنات الإقليمية. يؤكد الكاتب أن احتلال الموصل جاء بتنسيق داخلي وخارجي: انسحاب قادة الجيش السنة والكرد، سحب الشرطة المحلية، وتواطؤ سياسي وإعلامي وفّر الغطاء لداعش. النجيفي لعب دور الوسيط لا الحامي، فيما تعامل بارزاني والبيشمركة وفق خطط مسبقة لاقتطاع المناطق المتنازع عليها، حتى أن وزير داخلية الإقليم أعلن حدود كردستان مع “داعش” لا مع بغداد. واشنطن، بحسب مجيد، لم تكتف برفض تسليح الجيش بل وفرت غطاء سياسياً للتنظيم عبر خطاب “تهميش السنة”، فيما تحركت داعش بقدرات لوجستية ودعم خارجي. الانسحابات والتواطؤ المحلي سهلت مجازر دموية كبيرة مثل مجزرة سبايكر، التي كشفت ثوار العشائر ودور البعث والنقشبندية في التخطيط والانتقام.من زاوية أوسع، يربط المؤلف بين سوريا والعراق: مشروع “الخلافة” كان يهدف لإسقاط الأسد والمالكي معاً، لكن التدخل الإيراني والروسي في سوريا منع ذلك، بينما في العراق فُتح الطريق أمام داعش ليصبح أداة لإعادة ترتيب النفوذ الأميركي والإقليمي. احتلال الموصل لم يكن حدثاً عسكرياً فحسب، بل انعكاساً لصراع دولي استخدم الإرهاب لتفكيك الدول الوطنية وإعادة رسم الخرائط الطائفية والعرقية.يرى الكاتب أن السيد المالكي استشرف باكراً انتقال الخطر من سوريا إلى العراق، فدعا القوى الشيعية للتأهب وأطلق مبادرة لتأسيس قوة رديفة للجيش. ومع فتوى المرجعية العليا بالجهاد الكفائي تحولت الاستجابة الشعبية إلى اندفاع واسع أسس الحشد الشعبي، الذي لعب دوراً محورياً في قلب موازين المواجهة مع داعش بدعم إيراني مباشر، بينما ترددت واشنطن طويلاً قبل التدخل.يبيّن الكاتب أن الحشد الشعبي تعرض منذ نشأته لهجمة إعلامية داخلية وخارجية وصفته بالميليشيا الطائفية، رغم أنه كان القوة الأساسية في تحرير المناطق السنية. هذه الهجمة ارتبطت بمشروع أميركي لإعادة رسم توازنات المنطقة بعد 2017، ما جعل الحشد ليس قوة عسكرية فحسب بل حاجزاً أمام المخططات الإقليمية والدولية.في هذا السياق، برزت هزيمتان كبيرتان: الأولى للبيشمركة بعد فشل استفتاء الانفصال وانسحابها من كركوك، والثانية لداعش بخسارة مشروع “الخلافة” في 2017. الهزيمتان مثلتا انتكاسة استراتيجية للولايات المتحدة التي سعت إلى إضعاف الدولة العراقية.كما يكشف الكاتب عن الأدوار الإقليمية: السعودية دعمت خطاب الطائفية وروّجت لاتهام الحشد بالتبعية لإيران، فيما حاولت تركيا استغلال معركة الموصل لتوسيع نفوذها عبر وجود عسكري في بعشيقة، لكن بغداد رفضت مشاركتها. أما جامعة الدول العربية فاكتفت ببيانات بروتوكولية عاجزة.يخلص الكاتب إلى أن واشنطن لم تكن تحارب داعش بل تدير وجوده لإدامة استنزاف العراق ومنع صعود قوة مستقلة. غير أن ولادة الحشد الشعبي وشرعيته الدينية والشعبية قلبت المعادلة، لتصبح معركة الموصل مواجهة بين مشروع أميركي لإدامة الفوضى، ومشروع عراقي شعبي استعاد المبادرة ورسم ملامح عراق جديد بعد داعش.
|  قراءة استراتيجية لكتاب ((احتلال الموصل)) للكاتب الاستاذ ياسين مجيد
قراءة استراتيجية لكتاب ((احتلال الموصل)) للكاتب الاستاذ ياسين مجيد




 كتاب الدستور
كتاب الدستور أضيف بواسـطة addustor
أضيف بواسـطة addustor الكاتب ناجي الغزي
الكاتب ناجي الغزي أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة
 الشارقة للكتاب يحتفي بالشعر العالمي.. ومقهى الشعر يستضيف امسيات بثماني لغات
الشارقة للكتاب يحتفي بالشعر العالمي.. ومقهى الشعر يستضيف امسيات بثماني لغات
 قراءة استراتيجية في فشل الرهان على واشنطن
قراءة استراتيجية في فشل الرهان على واشنطن

 فنانون لهم حضور ابداعي في برنامج ((ادب وفن)) بمعرض الشارقة الدولي للكتاب
فنانون لهم حضور ابداعي في برنامج ((ادب وفن)) بمعرض الشارقة الدولي للكتاب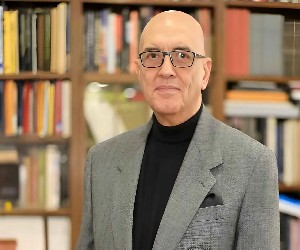
 الكاتب والمسرحي المصري محمد سلماوي «شخصية العام الثقافية» لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025
الكاتب والمسرحي المصري محمد سلماوي «شخصية العام الثقافية» لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025
 منكم وفيكم.. قراءة قرآنية في معنى الانتخاب
منكم وفيكم.. قراءة قرآنية في معنى الانتخاب
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


