 سوق العقول
سوق العقول
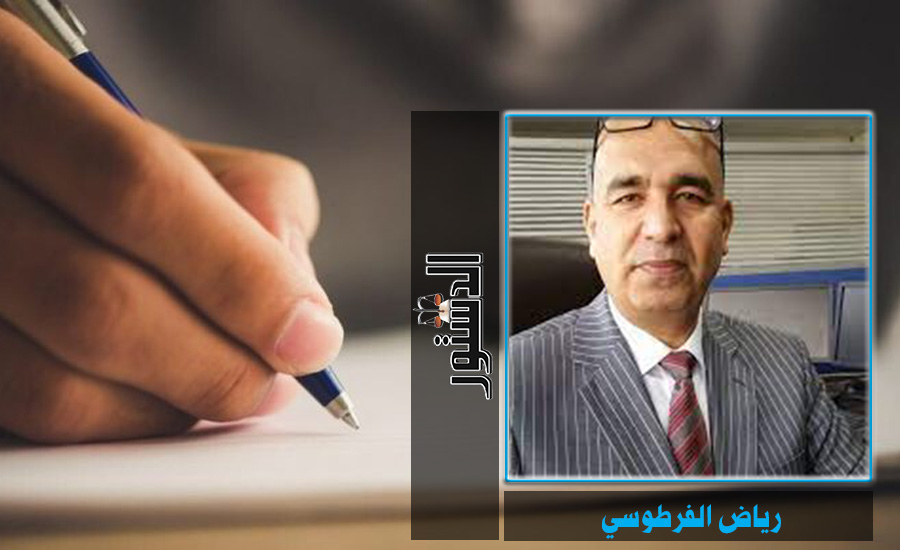 |
| سوق العقول |
  
|
 كتاب الدستور كتاب الدستور |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب رياض الفرطوسي الكاتب رياض الفرطوسي |
| النـص :
حين تُغلق العقول أبوابها، تتحول الأوطان إلى أقفاص جميلة.
في كل حضارة حقيقية، كانت الأفكار هي البضاعة الأثمن في السوق. فالمجتمع لا يُقاس بعدد ناطحاته ولا بوفرة موارده، بل بعدد العقول التي تفكر فيه بحرية، وبالأسئلة التي يجرؤ على طرحها دون خوف. في «سوق العقول» الحقيقي، تُعرض الفلسفة إلى جوار الأدب، ويُناقش الفن كما تُناقش السياسة، ويُعامل التفكير كحقّ طبيعي، لا كخطر يجب محاصرته.
لكن في مجتمعات القهر، تُغلق أبواب السوق، ويُصادر العقل كما تُصادر الكلمة. هناك يبدأ ما يمكن تسميته بـ«الخصاء العقلي»، حين يُمنع الإنسان من التفكير ويُربى على الطاعة العمياء. فيتحول المجتمع شيئاً فشيئاً إلى كتلة من العادات والمسلّمات، لا تسأل، لا تشك، لا تحلم. يُختزل العالم إلى لونين: أبيض وأسود. لا منطقة رمادية، ولا احتمالات أخرى. كل ما هو مختلف يُدان، وكل من يجرؤ على السؤال يُعاقَب بتهمة الشك في المسلمات.
في تلك البيئات، تتوقف العقول عن الإبداع وتكتفي بتكرار ما تسمعه. يصبح التفكير نوعاً من الخطر، والخيال ترفاً غير ضروري، والاختلاف خيانة. وعندما يغيب التفكير المنطقي، يحضر التفسير السحري لكل ما يحدث: فالغبار الأحمر يصبح غضباً إلهياً، والمطر الغزير عقوبة سماوية، والمرض اختباراً للولاء. إنهم لا يبحثون عن الأسباب، بل عن التبريرات التي تحفظ استقرار الوهم.
وقد فهم الطبيب والمفكر فرانز فانون هذه الظاهرة حين كتب عن المجتمعات التي خرجت من الاستعمار السياسي لكنها بقيت أسيرة الاستعمار النفسي. رأى فانون أن المقهور إذا لم يتحرر داخلياً من شعوره بالذل والعجز، فإنه سيعيد إنتاج جلاده حين يمتلك السلطة. وهكذا يتحول الضحية إلى جلاد جديد، يمارس على الضعفاء ما مورس عليه، كأن القهر يتناسل من جيل إلى جيل، لا ينتهي إلا حين يولد الوعي.
وما يحدث داخل المجتمع هو نفسه ما يحدث داخل البيت. فالرجل الذي يعيش تحت سلطةٍ قاهرة، غالباً ما ينقل القهر إلى زوجته وأطفاله. يحول بيته إلى قفص صغير ليمارس فيه سلطته، فيتوهم أنه استعاد كرامته، بينما هو في الحقيقة يكرّر صورة الطغيان نفسها التي عانى منها. إن القمع حين يتغلغل في النفس، لا يفرّق بين سلطة عليا وسلطة يومية. إنه مرض ينتقل بالعدوى، من الحاكم إلى المواطن، ومن المواطن إلى أسرته، حتى يصير الجميع حراساً لقفصهم.
ثم نراه يخرج إلى الشارع مطالباً بالحرية، هاتفاً بإسقاط النظام، وهو لا يدرك أنه يحمل النظام في داخله. فالنظام ليس مجرد جيش أو شرطة، بل هو طريقة تفكير وسلوك، عقلية ترى الناس درجات، وتعتبر السيطرة شكلاً من أشكال الكرامة. ولهذا، فإن أي ثورة لا تغيّر الوعي، لن تغيّر الواقع.
لقد قال الفيلسوف الألماني نيتشه قولًا عميقاً ومباشراً : «من يعرف سبب حياته، يستطيع أن يتحمل أي ظرفٍ يمرّ به.» ومعنى ذلك أن الإنسان إذا امتلك هدفاً واضحاً ووعياً عميقاً بمعنى وجوده، فلن تكسره الظروف ولا القهر. أما نحن، فقد فقدنا هذا «السبب»، لم نعد نعرف لماذا نحيا، ولا لأي غاية نفكر أو نتعلم، ولهذا صرنا هشّين أمام كل عاصفة، مترددين بين تقليد الماضي وخوف المستقبل.
إن المجتمع الذي لا يزرع في أفراده القدرة على السؤال، محكوم عليه أن يعيش في الظل. فالتربية التي تقتل الفضول تقتل الحرية، والتعليم الذي يُلقّن ولا يُناقش يصنع موظفين لا مفكرين. وحين يُستعبد العقل، يُستعبد كل شيء بعده: الجسد، والرأي، والحلم.
لهذا لا يكفي أن نطالب بتغيير الأنظمة، بل يجب أن نبدأ بتغيير ذواتنا. الحرية لا تبدأ في الشارع، بل في الذهن. تبدأ حين نجرؤ على قول «لماذا؟» في وجه كل سلطة تمنع السؤال، وحين نفهم أن التفكير ليس تمرداً، بل فعل حياة.
إن «سوق العقول» لن يُفتح بقرار سياسي، بل بقرار ثقافي. حين ندرك أن الفكر أثمن من الذهب، وأن الحوار أصدق من الشعارات، وأن المختلف ليس عدواً بل ضرورة لوجودنا، عندها فقط سنكون مجتمعاً حيّاً.
العقل ليس ترفاً، بل هو هواء الحرية. ومن دون هذا الهواء، تختنق الأمم حتى لو رفعت شعارات النهضة والإصلاح.
فالأوطان لا تبنى بالحماس وحده، بل بالوعي،
ولا تتحرر الأجساد ما لم تتحرر العقول. |
| المشـاهدات 37 تاريخ الإضافـة 20/10/2025 رقم المحتوى 67530 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة |
 نائب محافظ المركزي: 5 مصارف قد تخرج من السوق قريباً
تحذير من العقوبات الأميركية .. أفقدت الثقة بالمؤسسات المصرفية العراقية نائب محافظ المركزي: 5 مصارف قد تخرج من السوق قريباً
تحذير من العقوبات الأميركية .. أفقدت الثقة بالمؤسسات المصرفية العراقية |
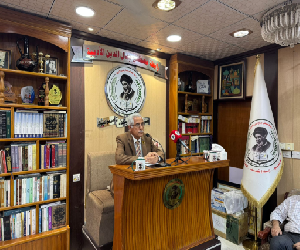 |
 رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية بالبصرة تضيف شاعر سوق الشيوخ علي مجبل المليفي رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية بالبصرة تضيف شاعر سوق الشيوخ علي مجبل المليفي
|
 |
 بدأت بتسجيل الغرامات إلكترونياً عبر الرادارات الذكية في بغداد
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف بدأت بتسجيل الغرامات إلكترونياً عبر الرادارات الذكية في بغداد
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف |
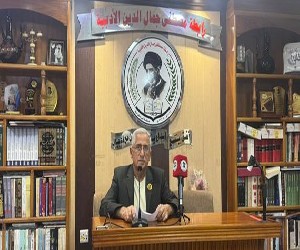 |
 رابطة مصطفى جمال الدين بالبصرة تضيف شاعر سوق الشيوخ خميس خضير رابطة مصطفى جمال الدين بالبصرة تضيف شاعر سوق الشيوخ خميس خضير
|
 |
 قبيل انطلاقه بحضور حكومي وعالمي رفيع
منتدى بغداد الدولي ..رؤية عراقية جديدة لتحديات سوق الطاقة قبيل انطلاقه بحضور حكومي وعالمي رفيع
منتدى بغداد الدولي ..رؤية عراقية جديدة لتحديات سوق الطاقة |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


