| النـص : أعزائي القراء،اسمحوا لي أن أفتح معكم اليوم “نقّاشًا” هادئًا في موضوع شغلني، بل ودوّخني، منذ فترة ليست بالقصيرة. موضوع لم أبتّ فيه حكمًا بعد، لكنه ما زال يدور بداخلي كأرجوحة أسئلة… تتأرجح بي كل يوم ولا تهدأ. فكّرت أن أشارككم هذه الأسئلة والظنون والاحتمالات، لعل عقولكم مع عقلي نصل إلى نقطة نور… أو حتى ضوء خافت نعلّقه على جدار الفهم. ولنبدأ من هنا، هل يُعقَل أن يقفز العقل البشري تلك القفزة الهائلة في ميدان الذكاء الاصطناعي، حتى كاد يلامس تخوم الخيال، بينما يقف على الضفّة الأخرى جامدًا، أسير ركودٍ يكاد يكون أبديًّا، في مجالاتٍ أكثر اتصالًا بحياتنا اليومية، وأقرب إلى نبض الإنسان واحتياجاته؟يظلّ متثاقل الخطى فيها، ونأخذ هنا المجال الصحي كمثال، وهو أوكسجين المستقبل وركيزة بقاء الإنسان. أراه راقدًا رقاد السلحفاة العجوز، المثقلة بأوجاع الروماتيزم، يتحرّك ببطءٍ مؤلم، وكأن الزمن يجرّه جَرًّا نحو الأمام دون أن يوقظه من غفوته الطويلة.في المقابل، أجد أن مجالات الذكاء الصناعي تُتسابق عليها الشركات والجامعات وكبار المستثمرين، وكأنهم في حلبة مصارعة تقنية، يرشقون المليارات هنا وهناك لتطوير خوارزميات لا تنام، وآلات تُفكّر أسرع من أصحابها!وهنا يتضح التناقض الذي بات يلازمني، يؤنسني أحيانًا، ويستفزّني غالبًا، خصوصًا وأنا أعيش اليوم في ما يُصنّف ضمن “العالم الأول” – حيث يُفترض أن كل شيء يتحرك بخطى توازي الذكاء، إن لم تسبقه.ومع ذلك، يبقى العجيب أن الذكاء الصناعي يبدو كأنه انطلق في سباق ماراثوني مع الزمن، بينما باقي المجالات الحيوية الأخرى ما زالت تلبس بيجاما النوم وتبحث عن زرّ القهوة! وهنا يبرز التساؤل المنطقي: أهو تطور انتقائي؟ أم خلل في أولوياتنا كبشر؟ هل نطوّر “العقل” الصناعي لنُعوّض فشل “العقل” البشري في اتخاذ القرار وتحمّل المسؤولية؟ أم أن الذكاء الصناعي تجاوزنا ببساطة… وتركنا نراوح مكاننا؟ إنها أسئلة كثيرة تنبثق تباعًا بلا إجابات حاسمة. لكن ما أعرفه تمامًا هو أن هذا التفاوت بين السرعة المذهلة هناك، والبُطء الفادح هنا، ليس عابرًا، بل علامة استفهام ضخمة يجب أن نقف عندها كثيرًا. ومن واقع تجربتي، حين أزور مراكز أبحاث الذكاء الصناعي، أندهش من حجم التقدّم العلمي: تحليل بيانات فورية، تشخيصات طبية آلية، روبوتات جراحية، ومركبات فضائية تتحكم بها أيدٍ بشرية عن بُعد.لكنني، في المقابل، أجد مريض السكر ما زال يتألم من وخز الإبر، ومريض الضغط يبحث عن حبة دواء بلا أعراض جانبية، ومريض فيروس C يتنقل بين مراحل العلاج كما يتنقل بين محطات المترو دون أن يصل للنهاية.والأدهى والأمرّ من ذلك، أن الحضارات القديمة – من دون الذكاء الصناعي – كانت تملك نظمًا طبية متقدمة في التشخيص والعلاج، نغبطهم عليها إلى اليوم! وهنا يطفو سؤال آخر: فكيف لنا أن نصنع روبوتًا يجري عملية جراحية كاملة، بل كيف نتحكم في مركبات فضائية على بُعد آلاف الأميال، ولا نتحكم بعدُ إلى الآن في خلية متمردة تنمو في جسد إنسان؟أي قوّةٍ هذه التي أوصلتنا إلى هذا الحدّ لصنع آلة تُحاكي العقل في تفكيره وجداله وعِناده، فيما يبقى العقل الحقيقي نفسه سرًّا عصيًّا علينا؟ كيف استطاع الإنسان أن يبتكر نسخة افتراضية من وعيه، بينما يقف حائرًا أمام أصل الوعي ذاته، لا يدرك كيف يتكوّن، ولا كيف يضطرب، ولا كيف يُشفى إذا اعتلّ؟ لقد استطعنا أن نصنع روبوتًا يتفوق علينا، وربما – وهذا الجزء الأصعب – بدأ يعصينا ويرفض تنفيذ الأوامر المعطاة له!أليست هذه، بحق، مفارقة الزمن الحديث؟ أن نغدق الأموال الطائلة على ذكاءٍ صناعيّ يَحاكي الإنسان، بينما نقف عاجزين أمام فيروسٍ ضئيل لا يُرى بالعين، أو أمام مرضٍ عرفناه منذ قرون ولم نحسن بعدُ علاجه؟ إنه لأمرٌ غير عقلانيٍّ على الإطلاق، على الأقل بالنسبة لي. ولكي أكون أكثر وضوحًا، لماذا إلى الآن ما زال الناس يعانون أمراضًا تنهش أعمارهم بصمت، وتسرق أيامهم قطرةً قطرة، في زمنٍ يُقال إنه زمن ثورة العلم والاكتشاف؟ كيف يستقيم أن تُسمّى بعض العقاقير “أدوية”، وهي في جوهرها أقرب إلى أسهم البورصة، تتقاذفها معادلات الربح والخسارة أكثر مما تحمل همّ الشفاء والراحة؟ كم من دواءٍ لا يداوي، بل يزيد الألم تفاقمًا، ويُضيف إلى ثِقَل الجسد ثِقَلًا آخر من الآثار الجانبية والمعاناة… حتى غدا الطب – في بعض وجوهه – سوقًا للتجارة أكثر مما هو رسالة لإنقاذ الأرواح. ومن هنا يتجدد السؤال القديم المتجدد: ما سرّ هذا العجز الطبي المزمن؟ لماذا لم تُصرف الأموال والأوقات بسخاءٍ وصبرٍ في الأبحاث الطبية كما صُرفت في سباق الذكاء الاصطناعي؟ لا زالت علوم الطب الآن، شرقًا وغربًا، تعاني من عجزٍ حقيقيٍّ في التخفيف عن معاناة الإنسان وتحقيق الحد الأدنى من الرفاهية له.نعم، نحن اليوم نُطوّر الروبوتات لتفكّر وتحلم وتكاد تحلّ محلّ الإنسان في كل مجال، لكننا في الوقت نفسه نترك الإنسان الحقيقي يتخبّط في صراعه مع الألم والعجز. في مفارقةٍ لافتةٍ أن أسلافنا البعيدين قد نعموا بصحةٍ وأعمارٍ أطول منّا، وكانت لديهم من المعارف والعلوم ما وفّر لهم حياةً أقل صراعًا مع المرض! حفرياتهم ما زالت شاهدةً على جراحات دقيقةٍ لم نفكّ أسرارها بعد، وكأنهم امتلكوا سرًّا ضاع من بين أيدينا. غير أن تلك العلوم اندثرت مع اندثار مكتباتهم، وأُطفئت أنوارها تحت نيران الحروب ونهب الحضارات.واليوم، ونحن نعيش سباقًا محمومًا لصناعة آلةٍ تفكر، أو سفينةٍ تغزو الفضاء، ننفق أموالًا طائلة هنا، بينما يهوي الإنسان إلى قاع الإهمال، تتراجع أعمارنا الفعلية، وتنخفض جودة الحياة في عصرٍ يملك فيه كل شيء… إلا الإنسان. فما جدوى، أعزائي، أن نُصعد إلى الفضاء، والإنسان ما زال يتألّم على سريرٍ في مشفى مهترئ، لا يجد دواءً ولا سندًا؟ وما قيمة أن يتحدث الروبوت بلغةٍ فصيحة، وقلوبنا عاجزةٌ عن الإنصات لصرخة إنسان؟وربما لأننا ما زلنا نهرب من أسرارنا الداخلية إلى مرآةٍ خارجية، فنصنع عقلًا بديلًا. فهل نحن حقًا نتقدّم، أم أننا نستبدل لغزًا بلغز، ونستعجل ظلًّا لنُغطي به عجزنا عن مواجهة الأصل؟ أحببت أن أشارككم هذا الطرح، علّني أجد في أفكاركم ما يُنير لي دربًا في رحلتي الطويلة للبحث عن إجابةٍ تقنع عقلي… وترضي قلبي. وربما لا أملك اليوم إجاباتٍ شافية، وربما سأظل أطرح ذات الأسئلة في صمتٍ موجع، في رحلتي بحثي عن الإنسان وسط تروس الآلات، وتنقيبي عن الرحمة في معادلات التقنية الباردة. ومن يدري… ربما آن الأوان أن نعيد ترتيب بوصلتنا، وأن نوجّه أنظار العلماء إلى الجرح الحقيقي لا إلى الظلال البعيدة، وأن تُساق الاستثمارات والأبحاث والأوقات لا نحو ما يُبهر العيون فقط، بل نحو ما يُنقذ الأرواح ويصون كرامة الإنسان. فالحضارة الحقّة ليست أبراجًا زجاجية، ولا آلاتٍ عملاقة، ولا تُقاس بعدد الشرائح الذكية، ولا بسرعة المعالجات، بل تُقاس بمدى قدرتنا على التخفيف عن كاهل الإنسان، على فهم ألمه، مداواة جراحه، واستعادة كرامته المسلوبة باسم التقدّم.إنها، باختصار، حضارة يظلّ فيها الإنسان في قمّة الهرم لا في قاعه، غايةً لا وسيلة، سيّدًا لا وقودًا. ولعلّ أبهى ما يمكن للبشرية أن تُنجزه إنسانًا آخر لا يُعاني… إنسانًا يُعاشره الأمل بدل الألم، وتُرافقه الراحة بدل العذاب.
|  سباق إلى الفضاء… وركود في غرف الإنعاش
سباق إلى الفضاء… وركود في غرف الإنعاش



 كتاب الدستور
كتاب الدستور أضيف بواسـطة addustor
أضيف بواسـطة addustor الكاتب دكتورة لمياء
الكاتب دكتورة لمياء أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة
 في الصميم
العراق بين ستيفاني وسافايا !!
في الصميم
العراق بين ستيفاني وسافايا !!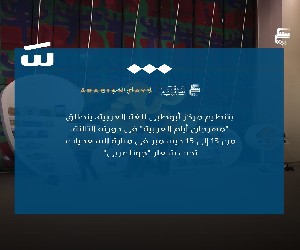
 أبوظبي للغة العربية ينظم مهرجان "أيام العربية" تحت شعار "جونا عربي" في أبو ظبي
أبوظبي للغة العربية ينظم مهرجان "أيام العربية" تحت شعار "جونا عربي" في أبو ظبي
 السينما المغربية في عام 2025
السينما المغربية في عام 2025

 زاخو يفوز على العين الإماراتي ويعزز صدارته في أندية كأس الخليج
زاخو يفوز على العين الإماراتي ويعزز صدارته في أندية كأس الخليج

 اوضحت آلية تصنيف الأسر كفقيرة وفقاً للدخل الشهري
التخطيط تبدأ إجراءات معالجة التفاوت بين رواتب الموظفين
اوضحت آلية تصنيف الأسر كفقيرة وفقاً للدخل الشهري
التخطيط تبدأ إجراءات معالجة التفاوت بين رواتب الموظفين توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


