 اختلال النقد: السلطة والشرعية وتآكل الخطاب النقدي
اختلال النقد: السلطة والشرعية وتآكل الخطاب النقدي
 |
| اختلال النقد: السلطة والشرعية وتآكل الخطاب النقدي |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص :
د. ضياء الثامري ظلّ النقد، في أرقى تصوراته، يزعم لنفسه وظيفة الوسيط بين العمل الفني وجمهوره، تتمثل في تأويله وتقويمه وربطه بأطر فكرية وتاريخية وسياسية أوسع. غير أنّ العقود الأخيرة شهدت ما يمكن تسميته بحالة اختلال بنيوي في الممارسة النقدية. والمقصود بالاختلال هنا ليس مجرد ارتباك مؤقت أو تحوّل طبيعي في طرائق النقد، بل أزمة أعمق تمس شرعيته وسلطته وفاعليته، وتطرح أسئلة جوهرية حول الشروط التي تمكّنه من أداء دوره. وقد تفاقمت هذه الأزمة بفعل تغيّر البنى المؤسسية، والتحولات في أنماط الإنتاج الثقافي، وزعزعة النماذج النظرية التي كانت تشكّل مرجعيات أساسية للنقد. يهدف هذا المقال إى مناقشة مظاهر اختلال النقد عبر ثلاثة محاور مترابطة: تآكل سلطة الناقد، وتَسْليع الخطاب النقدي وتفككه، والارتباك المعرفي الناتج عن تضخم الأطر التفسيرية وتنازعها. وسنحاول إظهار أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم بمجرد الدعوة إلى "عودة" لطرائق نقدية سابقة، بل يتطلب إعادة نظر جذرية في غايات النقد وأساليبه ضمن المشهد الفكري الراهن. تآكل سلطة الناقد أحد أبرز مظاهر الاختلال يتمثل في التراجع التدريجي لسلطة الناقد بوصفه حكماً ثقافياً. ففي منتصف القرن العشرين، ولا سيما في التقليدين الأنغلوساكسوني والفرنكوفوني، تمتع النقاد بموقع مهيمن؛ إذ كانت أحكامهم قادرة على صياغة الذائقة العامة، ورسم ملامح المتن الأدبي، وتوجيه الأجندات البحثية. شخصيات مثل ليونيل تريلنغ وسوزان سونتاغ ورولان بارت جسّدت مرحلة كان فيها للنقد حضور ثقافي فاعل، وتُستقبل فيه أحكام الناقد بوصفها مزيجاً من الصرامة الفكرية والتأثير الاجتماعي. لكن هذه السلطة تآكلت لأسباب متعددة، في مقدمتها دمقرطة الخطاب الثقافي التي عجّلت بها الثورة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. فقد تلاشت الفوارق بين صوت الناقد المحترف وصوت الجمهور العام، وهو تطور إيجابي من زاوية المساواة المعرفية، لكنه في الوقت ذاته قلّص من الوزن النوعي للخبرة النقدية. أصبح النقد الرقمي، وهو في الغالب، أسير منطق السرعة والانطباع الشخصي، أقرب إلى توصيات استهلاكية منه إلى تحليل متعمق، وتحوّل المعيار من الاستقلالية الفكرية إلى مقاييس الانتشار الافتراضي من إعجابات ومشاركات وخوارزميات. وبالاستعانة بمفهوم الحقل عند بيير بورديو، يمكن القول إن رأس المال الرمزي الذي كان يمنح الناقد سلطته أخذ يُعاد تعريفه وفق معايير السوق وليس وفق معايير جمالية مستقلة، الامر الذي جعل موقع الناقد هشّاً بين متطلبات التخصص الأكاديمي وضغوط التلقي الشعبي. تَسْليع الخطاب النقدي وتفككه المحور الثاني من الأزمة يتمثل في خضوع الخطاب النقدي لمنطق السوق وتفتته المؤسسي. فقد كان النقد، تاريخياً، يستند إلى أطر مؤسسية واضحة – مجلات و دور نشر وصحف وأقسام أكاديمية – توفّر له البنية المادية والانضباط المنهجي. أما اليوم، فقد تلاشت هذه الأطر أو ضعفت، ليحل محلها فضاء نقدي متشظٍ يضم أشكالاً متجاورة: كتباً أكاديمية ومقالات مطوّلة وتدوينات وبودكاستات ومقاطع مرئية، غالباً بلا معايير مشتركة للصرامة أو أسس موحدة للتحليل. ولا شك أن هذا التعدد يتيح انفتاحاً أكبر على أصوات وتجارب مهمشة، لكنه، في ظل خضوعه لاقتصاد الانتباه الرقمي، ينتج خطاباً نقدياً مصمَّماً لتلبية أذواق أسواق جزئية وجماعات هوية محددة. وهكذا يتحول الناقد إلى "منتِج محتوى" يخضع لمنطق السرعة وقابلية النشر الفوري، ما يضعف التحليل العميق ويفسح المجال لما تسميه لورين برلان بـ"التفاؤل القاسي"؛ أي الإيهام بوجود تعمق نقدي بينما الإطار الزمني وضغط السوق لا يسمحان بذلك فعلاً. كما يفضي هذا النمط إلى نقد أدائي الطابع، حيث تُستعمل الأحكام كإشارات انتماء أو تموضع أيديولوجي أكثر مما تُطرح كدعوات إلى نقاش مفتوح. ومع هيمنة هذا الاتجاه، يصبح النقد آلية لإعادة إنتاج الانقسامات الثقافية والسياسية، وليس فضاءً للمخاطرة الفكرية أو اختبار الفرضيات. الارتباك المعرفي وتعدد الأطر التأويلية المظهر الثالث للاختلال يتمثل في حالة الارتباك المعرفي الناتجة عن تضخم الأطر النقدية وتعددها غير المنضبط. فمنذ أواخر الستينيات، شهدت الدراسات الإنسانية انفجاراً في النظريات والمناهج: البنيوية وما بعد البنيوية والتفكيك والنقد النسوي وما بعد الاستعمار ودراسات الكوير ونظرية العرق النقدية والنقد البيئي ونظرية التأثر، وصولاً إلى ما بعد النقد . وقد وسّع هذا التعدد أفق الأسئلة النقدية وعمّقها، لكنه أفضى أيضاً إلى شعور بـ"الدوار الإبستمولوجي". ففي غياب أساس منهجي مشترك، تحوّل الحقل النقدي إلى أرخبيل من المقاربات غير القابلة دوماً للمقارنة أو القياس، وهو ما يحد من إمكانية بناء معرفة تراكمية أو صياغة معايير للحكم بين التأويلات المتضادة. ومع أن التعددية المنهجية يمكن أن تثري الحقل، فإنها، حين تنفصل عن أفق مشترك، تميل إلى إنتاج نسبوية مفرطة تُضعف الممارسة النقدية. وتتفاقم هذه الظاهرة بفعل "تأطير" النظرية داخل المؤسسات الأكاديمية، التي ترتبط فيها الانتماءات المنهجية أحياناً بالتحالفات الداخلية والهوية المهنية، فتتحول المنافسة بين المقاربات إلى "حروب نظرية" تتجاوز النصوص محل التحليل لتتمحور حول شرعية الإطار النقدي ذاته. تداعيات اختلال النقد إن تآكل سلطة الناقد، وتسليع الخطاب النقدي وتفككه، والارتباك المعرفي الناتج عن تعدد الأطر، كلها عوامل تدفع باتجاه انكماش جمهور النقد وانحسار مجاله المشترك. ومع تراجع الثقة العامة في النقد، وازدياد تخصصه أو انغلاقه داخل دوائر ضيقة، تقل قدرة الناقد على وصل جماهير مختلفة وإعادة وضع الأعمال في سياقات ثقافية كبرى. كما ينعكس هذا التراجع على الذاكرة الثقافية وتشكيل المتون الأدبية، إذ تصبح عمليات الحفظ والتدوين التاريخي والتقنين أقل استقراراً، وأكثر خضوعاً لأهواء اللحظة والاتجاهات العابرة. وقد يبدو ذلك ديمقراطياً من حيث انفتاحه على أذواق متعددة، لكنه يضعف من إمكان المراجعة النقدية العميقة على المدى الطويل. وتبرز كذلك إشكالية الدور التعليمي للنقد. ففي الجامعة، حيث يُدرَّس النقد بوصفه حقلا معرفيا، يجد المدرّسون أنفسهم أمام تناقض: فهم مطالبون بتدريب الطلبة على الصرامة المنهجية، في وقت باتت حدود هذا الحقل ومقولاته المعرفية محل سيولة وعدم استقرار. والتحدي هنا يكمن في الجمع بين تعليم تقنيات التحليل وغرس وعي تاريخي بمحدودية هذه التقنيات وارتباطها بسياقات مؤسسية. خاتمة إن اختلال النقد ليس عرضاً جانبياً للتحولات الثقافية، بل هو نتيجة مباشرة لتحولات بنيوية في العلاقة بين الإنتاج الثقافي والسلطة الفكرية والخطاب العام. ففقدان الناقد لسلطته يعكس إعادة توزيع رأس المال الرمزي، وتسليع الخطاب النقدي وتفككه يجسدان منطق الرأسمالية المتأخرة، أما تعدد الأطر التفسيرية فيمثّل الشرط ما بعد الحداثي الذي يجمع بين التعددية المنهجية وانعدام الإجماع. ومعالجة هذا الاختلال لا تكون بالحنين إلى ماضٍ نقدي أو بشعارات عامة عن "الصرامة"، بل بطرح سؤال جديد حول وظيفة النقد في عصر الوفرة المعلوماتية والتسارع الثقافي. ويتطلب ذلك قدراً من الشفافية المنهجية، وحواراً عابراً للأطر، ومقاومةً لردّ النقد إلى مجرد منتج استهلاكي. وقد يظل من غير المؤكد إن كان النقد قادراً على استعادة حيويته الفكرية في ظل هذه الظروف، لكن القبول بمزيد من تهميشه يعني خسارة أداة أساسية للحوار الثقافي ولإغناء المجال العام. |
| المشـاهدات 18 تاريخ الإضافـة 13/09/2025 رقم المحتوى 66605 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة |
 اللجوء للسلطنة للحفاظ على السلطة اللجوء للسلطنة للحفاظ على السلطة |
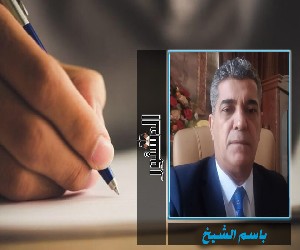 |
 الحساني وموجة تغيير الخطاب الحساني وموجة تغيير الخطاب |
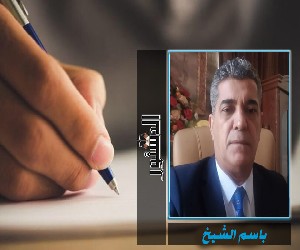 |
 الثقة بالسلطة التشريعية الثقة بالسلطة التشريعية
|
 |
 الخطاب الإعلامي الطائفي سم يقتل المجتمع : كيف تهدد الانتخابات وحدة النسيج الاجتماعي ؟ الخطاب الإعلامي الطائفي سم يقتل المجتمع : كيف تهدد الانتخابات وحدة النسيج الاجتماعي ؟ |
 |
 نائب: وزارة المالية سحبت 10 ترليونات دينار من الاحتياطي النقدي
جداول الموازنة المعلقة توقف رواتب المستفيدين الجدد من شبكة الحماية الاجتماعية نائب: وزارة المالية سحبت 10 ترليونات دينار من الاحتياطي النقدي
جداول الموازنة المعلقة توقف رواتب المستفيدين الجدد من شبكة الحماية الاجتماعية |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


