 البُعْدُ الرابعُ في البناءِ الفنيَّ للقصيدة
ديوان (أُسمِّي جُرحي شجرةً) للشاعر (طلال الغوَّار)
البُعْدُ الرابعُ في البناءِ الفنيَّ للقصيدة
ديوان (أُسمِّي جُرحي شجرةً) للشاعر (طلال الغوَّار)
 |
| البُعْدُ الرابعُ في البناءِ الفنيَّ للقصيدة ديوان (أُسمِّي جُرحي شجرةً) للشاعر (طلال الغوَّار) |
  
|
 فنارات فنارات |
 أضيف بواسـطة addustor أضيف بواسـطة addustor |
 الكاتب الكاتب |
| النـص : ميرفت أحمد علي/ سوريا لا تكادُ تدخلُ عتبةَ القراءةِ في (أُسمِّي جُرحي شجرةً)، وهوَ بيتٌ شعريٌّ مُستظِلٌّ بأفياءِ الشاعر (طلال الغوَّار)، حتى تتأججَّ انتباهاتُكَ، وتُستفزَّ ذائقتكَ وأنتَ تُمعنُ التفكيرَ في غيرِ قصيدةٍ وشطرةٍ وفكرةٍ في هذا الملكوتِ الباهي المشذَّبِ جمالياً، والمُهندمِ بعناصرهِ الإبداعيةِ الرائقةِ والمتجانسةِ ظاهراً وباطناً، حيثُ العلائقُ الوطيدةُ بينَ هندامِ القصيدةِ وسريرتِها، مرآتِها الشكليةِ ومراياها الداخليةِ الغائصةِ في غَياباتِ جبِّ يوسفَ حيناً، والعاكسةِ حيناً آخرَ لما يجري في تُخومِ سطحِ المعنى أو أدنى من السطحِ بقليلٍ... وهذا ـــ لَعمري ـــ فعلُ شاعرٍ بنَّاءٍ عتيقِ الخبرةِ في التأسيسِ والتعميرِ للفنِّ ومهاراتهِ أيتُها القصيدةُ كم سافرتُ فيكِ طويلاً لكني لم أجدْ منَ الطرقاتِ ما يكفي. وتتناثرُ ثُريَّاتُ المعنى وتُحَفُ وفازاتُ الأفكارِ الرشيدةِ في كل زاويةٍ من بيتِ الإبداعِ خاصَّتهِ، فتهتزُّ مرآةٌ هنا وينضحُ الدمعُ من إناءِ الجمادِ. والشاعرُ يتفننُ ويتماهرُ في شرحِ علاقةِ الأبِ بالابن في قصيدة (أبي): وأنا أشيرُ إلى النجومِ/ كنتُ أقولُ لأبي/ تلكَ دموعٌ تلمعُ في السماءِ/ فيبتسمُ لي/ وبعد سنينٍ طوالٍ / وهو يتكئُ على ابتسامةٍ مائلة /حدَّثني عن طفولتي وصِباي وسألني: كيفَ ترى النجومَ اللامعةَ الآن؟ وأنا أُصغي إليهِ وأتأمَّلهُ / رأيتُ نجوماً كثيرةً / تتلألأُ في عينيهِ. في متحفِ المعاني لدى (طلال الغوَّار) نلقى ما يكفي من التَّسامي والترقِّي بالسَّيلانِ الفكريِّ النازفِ المتحصِّلِ عن خيباتٍ مديدةٍ، وجراحاتٍ نفسيةٍ ونزوفٍ لاخضرار الحلمِ، والشجرِ، والرؤى المتناميةِ المتفرِّعةِ عن ذلك. فالجهادُ بالشعرِ فرضُ عَينٍ على كلِّ شاعرٍ، وهو احتراقٌ منعشٌ ولذيذٌ. يقول في قصيدةِ (الشعر) ص 71: الشعرُ مفترَقُ / فهُنا يوحِّدُني معي وهناكَ نفترقُ شجرٌ يُواكبني ويأسرُني وحيناً في أَتونِ الشوقِ أَنعتقُ الشعرُ جرحٌ نازفٌ في قامةٍ لليلِ لكنْ جرحهُ عبقُ هو غابةُ الأسرارِ في الأعماقِ تُشعلُها أصابعُنا ونحترقُ. لكنَّ طلال الغوَّار في هذا الديوانِ يُحسنُ إلى نفسهِ وإلينا ــــ أيَّما إحسانٍ ــ باختيارِ الجمالِ درعاً لصدِّ القبحِ والعَماءِ والتحييدِ عن منابعِ السعادةِ وسلسبيلِها، حتى لو كانتِ الحياةُ متلاحقةَ الأنفاسِ، وَمضَويَّةً، كفقاعةِ صابونٍ، بحيثُ لا يجدُ الشاعرُ وقتاً للاحتفاءِ بنفسهِ في الصباح: يا لَهذا الصباح! لم أَحتفِ بعدُ بنفسي / يمرُّ سريعاً /وتمضي بهِ الطرقاتْ /هكذا تمرُّ الحياة. والشاعرُ في لفتةِ انتماءٍ صادقةٍ وأمينةٍ إلى المنابعِ الوطنيَّةِ، لم يزلْ سادراً في ضلالةِ البحثِ عن صباحاتٍ لائقةٍ بالبلادِ. إنَّه كلما (تنفَّسَ قصيدةً) ذهبَ بعيداً في عتمةِ نفسهِ، ولم يعد يلمحُ البلادَ المشتهاةَ، يقول حينما (يرقبُ أحلامَهُ حتى طرفِ الروح) ص 58: عندَ النوافذِ ترتيلةٌ للرياحْ / ومن دُونها هل أرى / وطناً يخرجُ من جرحهِ عاشقاً/بثيابِ الصباح؟ وهو يعتذرُ من بلادهِ التي صدحتْ لها الأناشيدُ، ولم ترتِّقْ ثوبَها الذي قُدَّ من الخاصرة: عذراً للنجمةِ التي خلتُها يوماً / إيماءةً خضراء / وهرعتُ إليها / فاختنقتْ في خطواتي الأقاصي/ للشجرةِ التي تفيأتُ حلمَها/ ولم أعُدْ أراها غابةً للغناء / للبلادِ التي صدحْنا لها أناشيدَنا / ولم تُرتِّقْ ثوبَها الذي قُدَّ منَ الخاصرة فالقصيدةُ تغدو رمزاً نضالياً في مواجهةِ الاستقباحِ والاستجرامِ، تحفظُ ماءَ وجهِ مُبدعها من التلطُّخاتِ والاستذلالاتِ، وتصونُ عِفَّتهُ وتوازنَهُ النفسيَّين. إنَّه يتَّكئُ على صخرةٍ عندَ النهرِ، ينتظرُ موجةً كي تُلقي بين يديهِ قصيدةً: عندَ ضفافِ النهرِ / وأنا أتصفَّحُ وجهَ الماءِ /عثرتُ على إحدى القصائدِ. ورمزيَّةُ الدُّخانِ وتصاعدُهُ في قصيدةِ (دُخان) ص 55 ، تُحيلُ إلى دالَّةِ المجدِ والسؤددِ المُرتبطينِ تراثيَّاً بـ (العلَم، والنار التي على رأسهِ)، في إحالةٍ إلى الماجدينَ من الناس، وفي الإحالةِ إلى كرمِ الضيافةِ. فالشاعرُ الذي امتطى حروفَهُ لعقودٍ خمسةٍ في ترحُّلاتٍ شعريةٍ ميمونةٍ، وغزواتٍ مظفَّرةٍ، له أن يرسخَ في الذاكرةِ كنقطة علَّامٍ، كدُخانٍ، يُشار إليهِ بالبَنانِ، ناجمٍ عن الاحتراقِ بمُعاشرةِ الشعرِ. أنا ما اقتطعْتُ منَ الغابةِ غُصناً / وأشعلتُ فيهِ اللهبْ/ فمِنْ أينَ لي كلُّ هذا الدخان؟ ومِنْ أينَ لي/ كلُّ هذا الحطبْ؟ وبلغَ من ولَعِ الشاعرِ بالقصيدةِ أن صاغَ عشقَهُ لها صياغةً حكائيَّةً رشيقةً. إنَّه شاعرٌ انسلَّتْ من بينِ أصابعهِ نسمةٌ، فخبَّأَها منذُ طفولتهِ تحتَ ثيابهِ، لتغدوَ امرأةً تسقي أشعارَهُ رقةً، فيهتزُّ يقينُ الكلماتِ، وتزهو القصائدُ ولو في بارقةِ شكٍّ! وفي قصيدةِ (واهم) ص68، يُقرُّ الشاعرُ بفداحةِ العجزِ والشيخوخةِ الحقيقيينِ حينما نُضِلُّ دربَنا الصائبَ إلى الحقيقةِ، ونتشبَّثُ بالعنادِ ونحنُ نغلِّفُ قناعاتِنا المُتكلِّسةَ الصَّدئةَ بورقِ السيلوفان، فتَرشحُ منها العفونةُ والنَّتانةُ. ومعَ هذا التَّكلُسِ المُتراكبِ نُواجهُ جُبناً كبيراً يردعُنا عن الرغبةِ في التغييرِ، وفي النظرِ في عيونِ الحقائقِ الجميلةِ المُهملةِ والمُغيَّبةِ من حولنا. انظرْ إلى جمالِ الاستدلالِ على هذا المعنى: تربَّعْتَ عرشَ اليقينِ/ وقد بلغتَ بوهمِ الليالي عتيَّا / فتغمضُ عينيكَ / كيلا ترى زهرةً / يتفتحُ منها السؤالُ صباحاً بهيَّا / لماذا تخافُ؟ إذا أومأَ النجمُ يوماً إليكَ /وأيقظَ عندَ النوافذِ حُلماً قصيَّا / أتعرفُ يا صاحبي / أنتَ في الصدرِ ميْتٌ / ولكن ما زلتَ في الوهمِ حيَّا. وتشاغبُ القصيدةُ في خاطرهِ أحياناً ليبثَّ الشاعرُ (طلال الغوَّار) بعضَ الدُّعابة في أجواءِ قارئهِ، إذ يعلمُ جيداً أنَّه لا يبني أساساً للحرفِ في طينٍ، ولا في رمالٍ متحركةٍ، ولا في مياهٍ متقلِّبةِ الأحوالِ، لكنَّه يُوهمنا بذلكَ مُضفياً نكهةً نِكتيَّةً على الموقفِ التعبيريِّ: بنيتُ على الماءِ بيتاً لحُلمي / لأقرأَ في سورةِ الموجِ / وعدَ القطافْ/ ترى ما الذي سوفَ يحدثُ لو كسرَ النهرُ مرآتَهُ / ومشى عارياً في الضفافْ؟ وهذا مُناقضٌ تماماً لرابطةِ الدمِ والقرابةِ القويةِ بينَ المُبدعِ وإبداعهِ، الذي يرفعُهُ إلى السماءِ السابعةِ... يقولُ في (همسة) ص74 مرةً رفعتْني القصيدةُ إليها/ وراحتْ بعيداً / فاستدارتْ إليَّ وقالتْ بهمسِ / أَتدري إلى أين تمضي؟ / فقلتُ وهل غيرَ نفسي؟ وبلغَ من تصوُّفِ الشاعرِ وتماهيهِ مع قصيدتهِ حدَّاً نسَّكَهُ أبدَ الدهرِ، وزهَّدَهُ في سواها من شواغلِ الحياةِ، فحالُهُ حالُ المتصوِّفةِ في العباداتِ التي لا تكتملُ دائرتُها إلا برضا المعبودِ... وحالُ المبدعينَ الكبارِ ألَّا يرضَوا أبداً عمَّا يكتبون، وألَّا يشعروا بالاكتمالِ. فبعدَ خمسينَ عاماً ما زالَ الشاعرُ يحثُّ الخُطى نحوَ استرضاءِ الشعرِ: هناكَ/ حثثتُ القصيدةَ نحو حلمٍ جميلٍ / وكم كانتِ الكلماتُ في عجَلٍ / كي تصلْ / بعدَ خمسينَ عاماً / وما زالتِ الكلماتُ تتقرَّى الطريقَ / وأنا خلفَها لم أزلْ. ويمكنُ الوقوفُ على تخومِ قصائدَ ماجدةٍ انتقائيَّةٍ في مملكةِ (طلال الغوَّار) الشعرية، تستحقُّ كلٌّ منها إضاءةً مستقلةً، على سبيل المثال: (بناتُ النَّاي) وإشراقاتُها ومَرموزيَّاتُها، والومضاتُ الشعريةُ التي أفسحَ لها مكاناً صغيراً وإحالاتُها المُجيدةُ.. و(أنا عندي حَنين) التي تعَدُّ قراءةً في فلسفةِ الحنينِ لدى الشاعرِ... و (صباحٌ جميل) التي تعكسُ تخيُّلاتِ الصباحِ، وابتكاراتِ الشاعرِ لها ولطقوسِها.. وبديهيٌّ ألَّا يتَّسعَ المقالُ هنا للخوضِ فيها. ويبقى للشاعرِ في ذمَّتِنا أمانةُ أن نُحسنَ الظنَّ بمهاراتهِ في تشييدِ صرحٍ يُباهي به نُظراءَهُ من شعراءِ العربيَّةِ؛ فلقد أثَّثَ وزخرفَ بيتَ إبداعهِ برصانةٍ وبدقةٍ، وباصطبارٍ، فغدا بيتَ (حكمةٍ) قلَّما يُخالفهُ الصوابُ الفنيُّ والجماليُّ... إذْ لدى الشاعرِ (طلال الغوَّار) قدرةٌ على استدعاءِ بُعْدٍ رابعٍ دعَّمَ بهِ بُنيانَهُ الشعريَّ طيلةَ خمسةِ عقودٍ، بُعْدٍ يترجَمُ على أنَّهُ (سرُّ المهنةِ) حسبَ زَعمي.. ومَن دعَّمَ أركانَ فنِّهِ بأعمدةٍ إضافيةٍ؛ ضمنَ لها ألا تتضعضَعَ، وأنْ تخلدَ في ذاكرةِ القارئِ الذي يتشرَّفُ ببانيها وبمُؤسِّسها لَبِنةً لَبِنة، وحرفاً حرفاً، ونبضاً نبضاً.
|
| المشـاهدات 342 تاريخ الإضافـة 01/08/2023 رقم المحتوى 26675 |
 أخبار مشـابهة
أخبار مشـابهة |
 قصائد معطرة بلفيف الشجون نموذجا ديوان " وشاح من خجل " للشاعرة اللبنانية " ليلى بيز المشغرية " قصائد معطرة بلفيف الشجون نموذجا ديوان " وشاح من خجل " للشاعرة اللبنانية " ليلى بيز المشغرية " |
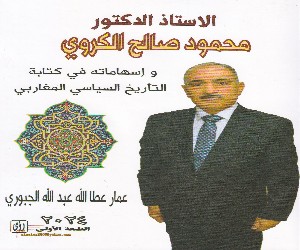 |
 اسهامات الدكتور محمود الكروي في كتابة التأريخ السياسي المغاربي اسهامات الدكتور محمود الكروي في كتابة التأريخ السياسي المغاربي |
 |
 التقاط الجزئي وخلق العوالم الجمالية
الجاذبة في( أراني اعصر حبرا) التقاط الجزئي وخلق العوالم الجمالية
الجاذبة في( أراني اعصر حبرا) |
 |
 القدرة على التقاط وتسجيل الاحداث
الواقعية والغرائبية في(تمثال الملك الباكي) القدرة على التقاط وتسجيل الاحداث
الواقعية والغرائبية في(تمثال الملك الباكي) |
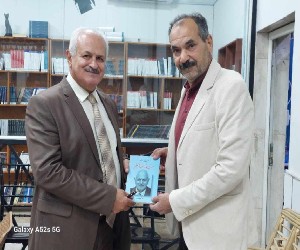 |
 الصدمة الناعمة
في قصائد الشاعر منذر عبد الحر الصدمة الناعمة
في قصائد الشاعر منذر عبد الحر |
 توقيـت بغداد
توقيـت بغداد 


